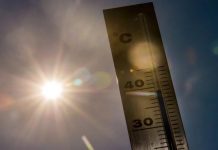أفريقيا برس – المغرب. في الحوار التالي، يحاول “أفريقيا بريس” مقاربة أهم أسئلة الراهن الحارقة، من قبيل تواتر محطات التطبيع العربي مع تل أبيب، وتفكك أواصر مجتمع دولة العدوان الصهيوني مع أكثر الحكومات تطرفا في إسرائيل، وإشكالية بناء الهوية في فرنسا، في ضوء اللوذ بالعلمانية القمعية ضد المسلمين كلما اشتدت الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وحمى الإسلاموفوبيا في أوروبا، وأزمة الدولة الوطنية في أفريقيا، في سياق موجة الانقلابات التي تشهدها القارة منذ سنوات ثلاث، ومعضلة المخاض السياسي الصعب نحو الديمقراطية في ليبيا وقضايا مغربية أخرى.
ومحمد أحمد بنّيس، هو باحث و شاعر وكاتب مغربي. حاصل على الدكتوراة في العلوم السياسية. له عدة دراسات وأبحاث ضمن منشورات “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” بقطر، الذي يديره الباحث والمفكر العربي عزمي بشارة، و”مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية” بالرباط. كما تنشر له بانتظام صحف ومواقع عربية مرموقة، مساهمات فكرية في متابعة وتحليل مستجدات الشأن السياسي المغربي والعربي والدولي.
أجرى الحوار: مصطفى واعراب
في ضوء ما يجري من حولنا، تسارعت في السنين الأخيرة وتيرة تطبيع الدول العربية مع إسرائيل، بشكل غير مسبوق.. على ماذا تراهن إسرائيل؟ وعلى ماذا تراهن الدول العربية المطبعة أو الساعية إلى التطبيع في السر وفي العلن؟
في تقديري تراهن إسرائيل على مزيد من الوقت من أجل إحداث اختراقات ثقافية داخل المجتمعات العربية، مستغلة في ذلك تردي الأنظمة التربوية في عدد من بلدان المنطقة، وتراجع أحزاب المعارضة وحركاتها التقليدية التي شكل التطبيع مع إسرائيل خطا أحمرا في أدبياتها. كذلك تراهن إسرائيل على إحداث اختراقات قانونية، بمعنى سن تشريعات وقوانين في الدول العربية تعتبر إدانة سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين معاداة للسامية، مثل ما حدث في الغرب. قد يكون هذا أمرا مستبعدا الآن، لكنه قد يصبح واقعا في السنوات المقبلة، مع تسارع وتيرة التطبيع بانضمام دول عربية جديدة.
بالنسبة للدول العربية المطبعة أو الساعية إلى التطبيع مع إسرائيل، فلكل دولة أولوياتها وحساباتها المرتبطة بإعادة الاصطفاف في الإقليم بعد فشل ثورات الربيع العربي واستعادة الأنظمة العربية زمام المبادرة. ولو أنها تشترك في تطلعها إلى الاستفادة من التحالف مع إسرائيلن على اعتبار أن هذا التحالف يجعلها تستفيد من الخبرة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية وتوظفها في التحكم في معادلة الاستقرار الاجتماعي والسياسي. هناك صعود للاستبداد في مختلف دول العالم ومؤشر الديموقراطية يتراجع، لذلك تبحث النخب الحاكمة كيف تعزز تحكمها وسلطتها بوسائل أكثر تطورا وقدرة على اختراق المجتمعات وتطويعها.
تشهد إسرائيل تصدّعا مجتمعيا على خلفية مشروع التعديلات القضائية، الذي تقدّمت به حكومة بنيامين نتنياهو التي جمعت وجوها وأحزابا من أقصى اليمين الصهيوني الديني.. هل شرع المشروع الصهيوني في التفكك، كما تنبأ بذلك البعض؟
من السابق لأوانه الحديث عن تفكك المشروع الصهيوني، على اعتبار أنه يتحرك ضمن ميزان قوى دولي يميل بشكل صارخ للقوى الغربية الكبرى التي تدعم الكيان الصهيوني، وتغذي بقاءه واستمراريته في المنطقة. وتغيير ميزان القوى هذا يتطلب تحولا عميقا في النظام الدولي الحالي. غير أن ذلك لا يمنع من القول، إن هذا المشروع يواجه مأزقا حقيقيا لأسباب كثيرة، أبرزها فشل دولة الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني على الرغم مما تمارسه في حقه من تقتيل وتشريد وتهجير وتدمير للبيوت. وقد سبق لزئيف جابونتسكي، أحد منظري الحركة الصهيونية، أن تنبأ، قبل عقود، بصمود هذا الشعب ورفضه التخلي عن وطنه للصهاينة. يُضاف إلى ذلك انسدادُ الآفاق أمام حل الدولتين بسبب الواقع على الأرض، والذي يتمثل في اتساع رقعة المستوطنات، ما يعني صعوبة الحديث، جغرافيا، عن دولة فلسطينية مستقلة ممتدة في الجغرافيا.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة حل الدولة الواحدة، وهو حل يهدد بنسف إسرائيل ديموغرافيا من الداخل. إذن حل الدولتين بات غير ممكن عمليا دون أن ننسى في هذا الصدد السكان العرب (1948) الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشكلون قنبلة ديموغرافية موقوتة بالنسبة لإسرائيل. حل الدولة الواحدة كذلك غير ممكن في ظل تغول أحزاب الصهيونية الدينية وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
يتجدد الجدل حاليا حول إشكالية بناء الهوية في فرنسا، في ضوء الحرب المعلنة على “العباية” في المدارس الفرنسية مع دخول العام الدراسي الحالي، التي يقودها الرئيس ماكرون شخصيا. لماذا يتم اللوذ بالعلمانية القمعية ضد المسلمين كلما اشتدت الأزمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؟ وبالموازاة مع ذلك، تشهد فترة حكم الرئيس ماكرون (الأولى والثانية) موجات غير مسبوقة ومتلاحقة من العصيان الاجتماعي: احتجاجات حركة السترات الصفراء، والمظاهرات الضخمة ضد “إصلاح” نظام التقاعد… وصولا إلى التمرد الخارجي في دول غرب أفريقيا والمغرب العربي.. هل هي مقدمات لأفول فرنسا على المسرح الدولي؟
مؤكد أن فرنسا تعيش أزمة مجتمعية كبرى، فهناك إشكالية الهوية التي تنذر بتعميق الانقسام داخل المجتمع، في ظل وجود قطاع من الفرنسيين المنحدرين من أصول عربية ومسلمةـ وفشلِ الدولة الفرنسية في التوصل إلى تسوية هوياتية تسمح لهؤلاء بالحفاظ على انتمائهم الديني والمسلم، من دون التفريط بهويتهم الوطنية باعتبارهم ولدوا وترعرعوا في فرنسا.
من دون شك، فإن النموذج الفرنسي في الإدماج قد وصل إلى الباب المسدود، خاصة أنه يتزامن مع تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وبداية تراجع دولة الطبقة الوسطى كنمط حياة، وأيضا بداية أفول النفوذ الفرنسي في إفريقيا. إذن هناك أزمة مجتمعية وهوياتية داخلية في فرنسا تغذيها أزمة الوجود الفرنسي في إفريقيا، وعجز الدولة العميقة في فرنسا عن إعادة صياغة أولوياتها وفق المتغيرات الحاصلة في العالم.
عاد الجدل ليحتدم من جديد حول أزمة الدولة الوطنية في أفريقيا، في سياق موجة الانقلابات التي شهدتها القارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. هل تمثل هذه الانقلابات بالفعل دليلا على فشل بناء الدولة الوطنية، بعد مرور ستة عقود على حصولها على استقلالاتها؟
نعم، إلى حد كبير تمثل هذه الانقلابات دليلا على فشل بناء الدولة الوطنية. فقد فشلت النخب في الدول الإفريقية في بناء الاجتماع السياسي الوطني الذي يتجاوز النعرات الإثنية والقبلية، لتفسح المجال أمام تشكُّل سلطويات استبدادية، عسكرية ومدنية، عكست في الغالب هيمنة مكون إثني أو قبلي بعينه. وعلى الرغم من أن دولا كثيرة في إفريقيا تنظم الانتخابات بشكل منتظم، إلا ان ذلك لم يحل دون استمرار هذا الوضع، فالديموقراطية تتطلب قبل كل شيء عقدا اجتماعيا جديدا يتجاوز الانتماءات التقليدية نحو رابطة المواطنة، من دون احتكام لمنطق الأقلية أو الأغلبية القبلية والإثنية.
بطبيعة الحال، لم تكن القوى الاستعمارية السابقة بعيدا عن هذا الوضع، بتحالفها مع القوى والنخب المحلية التي ستحمي مصالحها، المتمثلة بالأساس في الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها الدول الإفريقية. إن استمرار هذا الوضع سيفاقم أكثر الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في عدد كبير من دول إفريقيا، وسيرفع من أعداد المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، وسيعمق أزمة الدولة الوطنية في دول إفريقيا.
أعاد حرقُ نشطاء من اليمين المتطرف للمصحف، في السويد وهولندا والدنمارك، إلى الواجهة أسئلة الإسلاموفوبيا في الغرب.. هل هذه الحرب الدينية مظهر من مظاهر عودة اليمين المتطرف الذي يقرع أبواب أوروبا بقوة، أم إنها انعكاس “طبيعي” للحرب الغربية المعلنة على “الإرهاب الإسلامي”؟
لا يمكن أن نقول إنها حرب دينية مفتوحة على الإسلام في أوروبا، على اعتبار أن المجتمعات الأوروبية ليست كتلة متجانسة في تعاطيها مع الإسلام والمسلمين المقيمين بداخلها. إن تواتر حوادث حرق المصحف يعكس أزمة الحكومات الأوروبية في مجابهة الإسلاموفوبيا داخل مجتمعاتها. ويمكن القول، إن هذه إحدى واجهات الأزمة العميقة التي يواجهها الخطاب الغربي في حقوق الإنسان؛ إذ كيف نقيم تسوية معيارية (حقوقية) بين حرية التعبير والحق في إبداء الرأي بشأن ما يتعلق بالأديان، وبين احترام معتقدات الآخرين وعدم النيل منها. يتعلق الأمر، في الواقع، بصراع ثقافتين تقفان على أسس فكرية مختلفة تماما.
في السياق ذاته، هذا لا يمنع من القول إن معظم الجاليات العربية والإسلامية، فشلت في تقديم إسلام يعكس نمط عيشها في الغرب واندماجها فيه. لماذا تصر المؤسسات التي تمثل هذه الجاليات، مثلا ، على استقدام أئمة من دول عربية أخرى بدل تكوين أئمة محليين، ضمن شروط ثقافية أكثر ارتهانا لواقع المجتمعات الأوروبية والغربية.
تعيش ليبيا منذ 12 سنة مخاضا صعبا نحو الديمقراطية، بما تعنيه هذه الأخيرة من مؤسسات منتخبة وتوزيع عادل للثروة والسلطة بين جهات الوطن الواحد.. وأمام فشل الحل العسكري واستمرار تعثر الحل السياسي، هل الحل الوحيد المتبقي للخروج من النفق هو قيام “جماهيرية” ثانية، كما بات يطالب بعضهم؟
ما تعيشه ليبيا هو في الواقع تحصيل حاصل. بمعنى، إن احتكار السلطة خلال الفترة الطويلة التي حكم فيها معمر القذافي كان لا بد أن يؤدي إلى تجفيف منابع السياسة، في ظل غياب الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني. ومع تهاوي نظام القذافي وغياب بديل سياسي متوافق عليه بين الليبيين انفرط عقد ما كان يبدو دولةً، لتدخل ليبيا مرحلة الفوضى. طبعا هذا الوضع غذّته بنية التنظيم الاجتماعي في ليبيا، وهي بنية تقليدية كما نعلم، تقوم على أساس القبيلة. حل الجماهيرية الثانية سيعني شيئا واحدا؛ نجاح فلول النظام السابق في العودة إلى السلطة، كما حدث في بلدان أخرى. الحل في ليبيا، في تقديري، يبدأ بإيجاد توافق قبلي جهوي بين مختلف المناطق والجهات وتجاوز الحساسيات القبلية والعشائرية، والقبول بتسوية سياسية تحفظ مصالح الجميع.
بالعودة إلى المغرب، تحل بعد أيام سنتان على استلام عزيز أخنوش مقاليد الحكومة المغربية. هل خابت انتظارات المغاربة من حكومته، أم إن الوقت ما يزال مبكرا لإصدار حكم موضوعي حول أدائها؟
في تقديري لم تأت الحكومة المغربية الحالية بجديد، ليس فقط لأن هامش الحركة أمامها، من الناحية الاقتصادية، ضيق، بل أيضا لأن معظم الحكومات المغربية التي جاءت بعد إقرار سياسة التقويم الهيكلي (1983) كانت محكومة بالتوازنات المالية والاقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية. هذا الوضع بات بنيويا في عمل الحكومات المغربية، بصرف النظر عن لونها الحزبي. وتغيير هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في علاقة المغرب مع المؤسسات الدولية المانحة. وهو أمر يكاد يكون مستحيلا الآن، لاعتبارات يطول الخوض فيها.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للزلزال الذي ضرب إقليم الحوز تداعيات على مالية الدولة، ما يعطي الحكومة الحالية مسوغا آخر لإدارة ما يُفترض أنها التزمت به في برنامجها الحكومي. أكيد أن جائحة كوفيد-19 والزلزال والوضع الدولي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، كلها عوامل ستجعل الحكومة أكثر صرامة في تغليب التوازنات المالية، على حساب التوازنات الاجتماعية على ما في ذلك من مخاطر.
وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، فإن الطبقة المتوسطة شكلت أكثر من 60% من المجتمع المغربي في سنة 2014، حيث كان 67,5 % من سكان المدن من الطبقة الوسطى.. وفي غياب إحصائيات حديثة، سبق أن أفادت تقارير بأن الطبقة الوسطى تراجعت كثيرا بسبب وباء كوفيد-19 وتداعياته.. ماذا يعني ذلك على مستوى الواقع؟
يعني ذلك الكثير. فقد شكلت الطبقة الوسطى عنصر توازن داخل المجتمع المغربي لعقود طويلة. كما أنها تحملت التبعات الاجتماعية لسياسة التقويم الهيكلي، وما تفرّع عنها من تدابير وإجراءات في هذا الصدد. كذلك عملت هذه الطبقة على تغذية الأحزاب الوطنية والنقابات بكفاءات متعددة. كذلك شكلت مصدر إثراء للثقافة المغربية، على اعتبار أنها مصدر رئيس للمثقفين والكتاب والخبراء ومنتجي الأفكار وغيرهم.
إن تراجع هذه الطبقة ليس وليد الجائحة وتداعياتها، بل يعود إلى ما قبل ذلك. لكن يمكن القول إن تداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي لعدد كبير من شرائحها سيُحكم عليها الخناقَ أكثر، لاسيما في ظل السياسات الاجتماعية المعمول بها (تقلص التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية، تجميد الأجور، تداعيات الجائحة والزلزال..). والواقع الحالي ينبئ بأن قاعدة هذه الطبقة ستزداد تقلصا في ظل غياب سياسات اجتماعية منحازة لها.
يجرنا الوضع السياسي والاجتماعي في المغرب، إلى الحديث عن قضية الانتخابات والصراع الاجتماعي (حتى لا نقول الصراع الطبقي) في المغرب.. بشكل عام، هل يخدم المسلسل السياسي قضية الديمقراطية، أم إنه يخدم بشكل خاص فئة اجتماعية دون غيرها؟
بالتأكيد المسلسل السياسي الحالي لا يخدم الديموقراطية على المدى البعيد. فالمنعرج الذي حدث في 2011 بصدور دستور جديد، لم يفرز امتداداته داخل الحقل السياسي لأسباب بنيوية، منها بنية السلطة التي يشكل التقليد عصبها الرئيسَ، وتراجع قدرة النخب السياسية على إحداث بعض التوازن في ميزان القوى داخل هذا الحقل، خاصة بعد رحيل الزعامات الحزبية التاريخية داخل الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية، وتهرب حزب “العدالة والتنمية”، حين كان على رأس الحكومة، من تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة على أرض الواقع. هذا إضافة إلى الأزمة العميقة التي تعرفها الأحزاب السياسية في العالم، نتيجة سيطرة الرأسمال ورجال الأعمال عليها بطرق مختلفة.
المسلسل السياسي الحالي يخدم فقط النخب السياسية لأنه يخدم مصالحها على الرغم من أن الدستور الجديد نص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة. تصبح السياسة بهذا المعنى صراعا محتدما داخل الأحزاب والنقابات على المنافع المادية والرمزية، التي يتيحها القرب من دوائر السلطة وامتيازاتها المختلفة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس