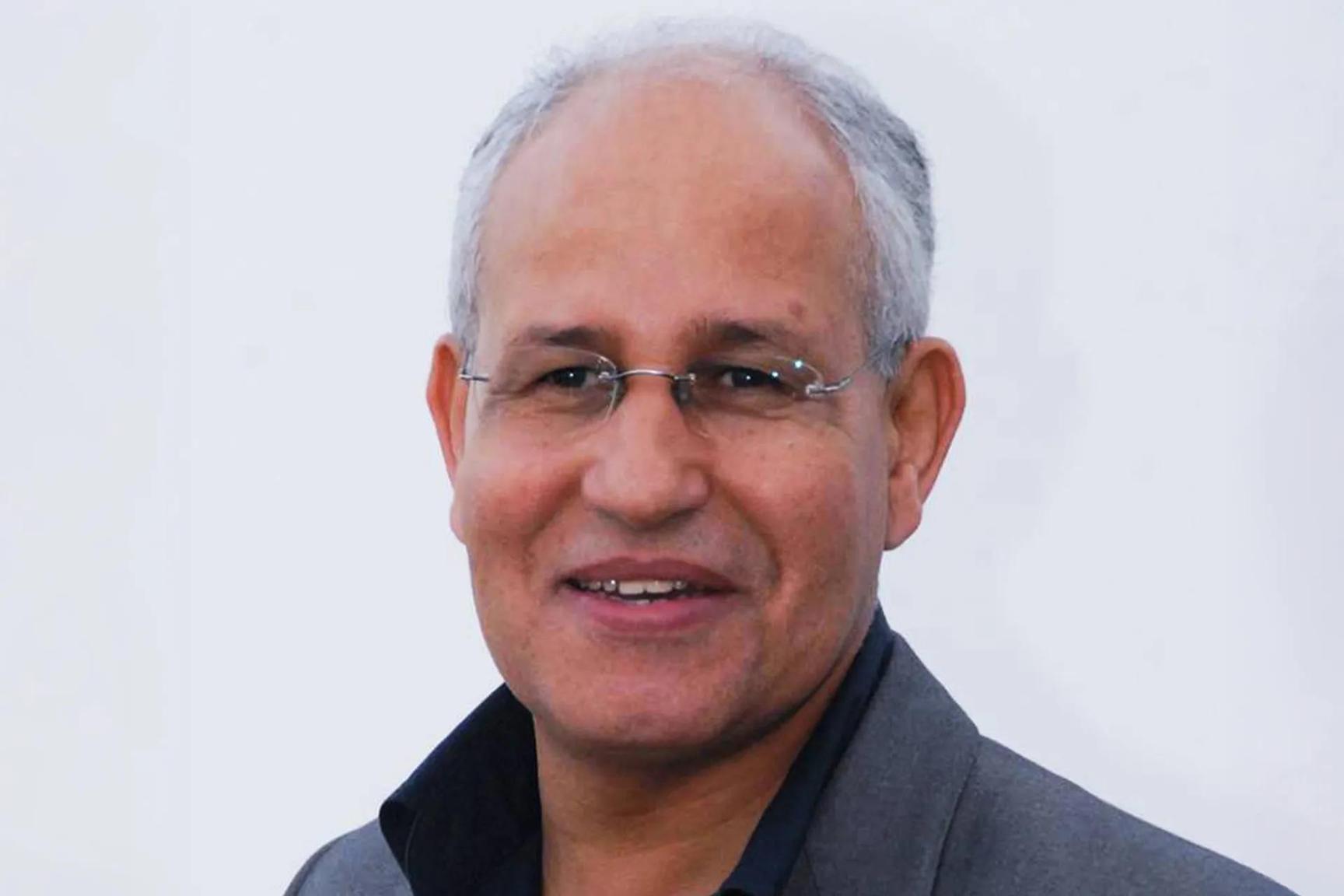سعيدة شريف
أفريقيا برس – المغرب. يقوم المشروع الفكري للأكاديمي المغربي محمد نور الدين أفاية على مفهوم النقد، فقد اهتم منذ دراساته الجامعية وكتاباته الأولى بالنقد الفلسفي والجمالي، وغاص في مدارات التفكير النقدي وسياقاته وأدواته وأهدافه الإنسانية والكونية.
كما قدم العديد من الكتابات والدراسات المهمة التي لم تقتصر على المجال النظري النقدي الفلسفي فحسب، بل تجاوزها إلى البحث في أسئلة الهوية والغيرية، والدولة والمجال العام، والإبداع والتواصل والفكر الجمالي، وتحديدا المجال السينمائي وثقافة الصورة التي أنتج فيها مجموعة من الأعمال الفكرية المهمة.
فهذا الاهتمام بالنقد في الإنتاج الفكري والنظري والثقافي وضرورته، لا يأتي من فراغ لدى الدكتور محمد نورالدين أفاية، الذي تم تنصيبه في بداية عضوا دائما بأكاديمية المملكة المغربية، وهي أعلى هيئة فكرية بالبلد، فهو نابع من إيمانه بأن الفكر النقدي يستمد جدارته، ويستحق تسْميتَه، ويكتسب وظيفتَه كلما انتزع لذاته فضاءً مناسبًا في الإنتاج الفكري والنظري والثقافي والسياسي.
الفلسفة لديه لا يمكن أن تنهض من دون أن تكون “نقدًا”، خاصة أن “الفلسفة تحيا بالنقد، والنقد يحيا بالفلسفة”، كما يقول.
ومهمة الفكر النقدي تتمثل بالأساس في مساءلة البداهات، وخلخلة أطر التفكير والمناقشة التي تستهدف تعليب العقول، واستلاب إرادتها وإخضاعها وتعريضها لـ”العبودية الطوعية” التي أنتجتها وسائط التواصل الاجتماعي، وما ينجم عنها من إضعاف لملكات الإنسان على الانتباه والتركيز والتفكير.
ويشير صاحب كتابي “الديمقراطية المنقوصة” و”النهضة المُعلقة” إلى أن جميع المؤشرات التي على أساسها تم تصنيف الدول في العالم والبلدان العربية، ومن ضمنها المغرب، تشير إلى أن نهضتنا ستظل “مُعلقة” طالما لم نعرف كيف نستثمر في البنيات الأساسية بمقدار ما نستثمر في بناء الإنسان والرأسمال البشري.
ويؤكد أنه “حين يتمكن أصحاب القرار من تغيير التوجهات والاختيارات الكبرى، وينجزوا عمليا ما أعلنوا عنه افتراضيا، ويشعر أكبر عدد من الناس بمردودية هذه الاختيارات في عيشهم، وحريتهم، وكرامتهم، وإنسانيتهم حينها يتعين تغيير قاموس الوصف ومعايير التقييم”.
أغنى أفاية المكتبة المغربية والعربية بمجموعة من الدراسات القيمة باللغتين العربية والفرنسية، توزعت على حقول معرفية متنوعة، وشملت مواضيع مختلفة، حيث كتب في الفلسفة والسينما وحول المرأة والهوية والتحولات الاجتماعية وسؤال النهضة، ناهيك عن بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بالتاريخ العربي.
ومن بين كتاباته نذكر “الديمقراطية المنقوصة، ممكنات الخروج من التسلطية وعوائقه” (2013)، و”في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية” (2014)، و”في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية” المتوج بجائزة أهم كتاب عربي لدورة 2015 التي تمنحها مؤسسة “الفكر العربي” ببيروت.
كما أصدر كتاب “الوعي بالاعتراف: الهوية، المرأة، المعرفة” (2017)، و”النهضة المعلقة” (2021)، و”الزمن المنفلت: هل ما يزال المستقبل مرغوباً فيه؟” (2024)، ثم “ضفاف النظر.. لغة بصرية مشتركة في حوض المتوسط” الصادر حديثا باللغة الفرنسية ضمن منشورات مؤسسة مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط.
وعن مشروعه الفكري واهتمامه بالنقد في مختلف المجالات والقضايا التي تناولها، ومن ضمنها كتابه الأخير عن المتوسط، كان هذا الحوار للجزيرة نت معه:
يقوم مشروعك الفكري على مفهوم النقد، فمنذ كتاباتك المُبكرة وإلى الحالية التي أغنت المكتبة العربية، غُصت في مدارات التفكير النقدي وسياقاته وأدواته وأهدافه الإنسانية والكونية، وبعد هذا المسار المهم، ما هو المفهوم الذي يقدمه اليوم الأستاذ أفاية للنقد والفكر النقدي بشكل عام؟
صحيح أنني اهتممت، منذ دراستي الجامعية، بمسألة النقد في الفلسفة والجماليات وشكَّل، باستمرار، انشغالا نظريا في معالجة العديد من الموضوعات التي وجدت نفسي أكتب عنها، سواء أتعلق الأمر بالنظرية النقدية، وبالهوية والغيرية، بالدولة والمجال العام، بالإبداع والفكر الجمالي، بالتواصل واستراتيجيات التلاعب والاستخدام، إلى غيرها من القضايا التي اقتربتُ منها في التدافع الفكري.
وسواء اكتفينا بلفظة النقد أو ما تواطأ الناس على تسميته “الحس النقدي” يتعرض لكثير من الالتباس، وللاجترار في الغالب الأعم، فإنه يصعب ادعاء تقديم “مفهوم” عن النقد خارج ما اقترحه المفكرون والفلاسفة الذين جعلوا من النقد أفقا لتفكيرهم، ومنطلقا لمعالجتهم لأحداث التاريخ، وظواهر المجتمع، وتحولات مقولات الفكر، والتباسات السياسة، وتجليات الجمال.
وأحسب أن كل نشاط فكري أو اجتماعي أو سياسي يمكن أن يكون نقدًا كلما أنتج معنى جديدًا، قادرا على تغيير، أو تعديل منطوق نص أو معنى أو علاقات ما؛ بل إن النقد قد يوجد، بشكل أصلي، في لعبة اللغة، وفي تصورات ونظرات وممارسات ناتجة عن مسافة مُولدة للاختلاف.
يستمد الفكر النقدي جدارته، ويستحق تسْميتَه، ويكتسب وظيفتَه كلما انتزع لذاته فضاءً مناسبًا في الإنتاج الفكري والنظري والثقافي والسياسي؛ بحيث لا يمكن الوصول إليه من دون تفكير مُنتبه إلى العمل الفلسفي والفكري، باعتباره تفكيرًا تساؤليًا، مجادلاً، برهانيًا، وباحثًا عن المعنى.
لذلك ثمة من يرى أن النقد شكَّل ويشكل دائما قضية نقدية بل وتبدو تسمية النقد صفة زائدة، لأنه يميز كل خطاب يفكر بالفعل.
مساءلة البداهات في عصر التشتت
وقد عرف تاريخ النقد، باعتباره ترجمة لفعل التفكير في الوجود، مرجعيات توزعت بين النقد المعياري، والأكاديمي، أو الإيديولوجي، انطلاقًا من اعتبار النقد شرط إمكان تأسيسي لكل فكر كما أسس له كانط، مرورًا بالنقد الجسور للاقتصاد السياسي بهدف التغيير الاجتماعي عند ماركس، إلى التمظهرات المختلفة للإخفاق الثوري التي أدت بما سماه تيودور أدورنو “بالجدل السلبي” إلى آخر انفتاحات ديريدا التفكيكية. هذا إن حصرنا نظرنا في تاريخ الفكر النقدي الأوروبي.
إن المهمة النظرية والتاريخية، بله السياسية، للفكر النقدي تتمثل، بالأساس، في مساءلة البداهات، أو ما يبدو كذلك، وكشف تداعيات “الدوكسا” Doxa السائدة (المعرفة الشائعة والسطحية)، وخلخلة أطر التفكير والمناقشة التي تستهدف تعليب عقول الناشئة، واستلاب الإرادات، والتشويش على حرية الكائن، وإلهائه بمظاهر الأمور، وإغراءات الاستهلاك، وإخضاعه لما يستنفر الإدراك والانفعال.
ولعل الجميع ينتبه، اليوم، إلى أن قسما كبيرا من البشرية عرَّض ويُعرض نفسه للعبودية الطوعية التي أنتجتها وسائط التواصل الاجتماعي، بما نجم عنها من إضعاف لملكات الإنسان على الانتباه، والتركيز، والتذكر، والتعلم الرصين وما يترتب عن غياب هذه الملكات من تراجع للفكر النقدي.
وأما ما يوفره الذكاء الاصطناعي من عروض وفتوحات ذات جوانب إيجابية لا شك في ذلك، فإنه يشكل، في نظري، تدميرا سريعا لهذه الملكات، وانحسارا للاجتهاد الفكري، إن لم يعمل الفاعلون كافة على التنبيه إلى استنهاض بعض مقومات اليقظة النقدية لكشف تعبيرات “الدوكسا” الجديدة.
في كتابك “في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربية وتجلياته العربية”، الفائز بجائزة أهم كتاب عربي لدورة 2015 التي تمنحها مؤسسة “الفكر العربي” ببيروت، سلطت الضوء على أهمية وضرورة النقد في الإنتاج الفكري والنظري والثقافي، وقلت بأن “الفلسفة تحيا بالنقد، والنقد يحيا بالفلسفة”، فما معنى أن تكون الفلسفة نقدا والنقد فلسفة؟
من المعلوم أن تاريخ الفكر الفلسفي الأوروبي الحديث والمعاصر اقترن بالنقد. وهو يتخذ عند كل فيلسوف حمولة دلالية خاصة، بحكم أن العقل الغربي، منذ إعادة البناء الحديثة لأساسياته، ارتبط بالاستعداد شبه البديهي لمراجعة قواعده وطرق اشتغاله، وذلك من خلال الاستحضار الدائم للسؤال، والنزوع المعلوم للنقد. تنطبق هذه الملاحظة على غالبية المنظومات والاجتهادات الفلسفية.
ولعل التراث الفلسفي النقدي الألماني يشكل تراثًا لا مناص من العودة إليه من طرف كل مشتغل بالسؤال الفلسفي وبالبحث في قضايا الفلسفة النقدية. منذ كانط، مرورًا بهيغل، وماركس، وشوبنهاور، إلى نيتشه، وهايدغر، والنظرية النقدية بأجيالها، نادرًا ما نجد اجتهادًا فلسفيًا معاصرًا أو يدعي انتماءه لما بعد الحداثة، لم يعد إلى اسم من الأسماء المذكورة، سواء من منطلق التبنّي، أو إعادة البناء، أو التجاوز.
المهم أنه يصعب فصل التطور الدلالي لمفهوم النقد عن مختلف ومستويات حضور أسماء كانط، هيغل، ماركس، نيتشه، حتى من طرف من يتقدّم إلى الحقل الفلسفي باقتراح “براديغم” جديد للنقد باسم الاختلاف أو التفكيك، كما هو حال دولوز وديريدا.
فعمل النقد في الفلسفة، كما هو الشأن لدى فيلسوف مثل دولوز يظهر من خلال العمل المستمر على اختراق الثنائيات التي تجثم على الفكر والثقافة وتكسيرها، وإبراز الاختلافات التي تختزن، هي بدورها، تعبيرات وأشكالاً من التعدد. ولا مجال للبحث عن هوية، كيفما كانت، إلا من خلال الاختلافات الثاوية في الأشياء، والأجساد، والحياة.
ما يهم الفيلسوف هو استثمار النقد للتحرر من كلّ أشكال الأسطرة التي تشوّش على الحياة، بل و”تُسمّمها” كما هو الشأن بالنسبة إلى الأخلاق؛ لأن معايير الخير والشر تخرج وتنبثق من إيقاعات الحياة؛ أي أن فلسفة دولوز، مثلا، تشجّع على كلّ ممكنات المبادرة والإبداع لنسج حياة مغايرة، واعتبار فعل الإبداع فعل مقاومة أكثر مما هو أداة للتعبير أو التواصل، لأنها مقاومة ضد الأفكار المسبقة، والكليشيهات، والحس المشترك.
منذ “الربيع العربي” وإلى اليوم مع “طوفان الأقصى” وتحركات “جيل زد”، والعالم العربي يعرف “فوضى عارمة” تشوه فعالية الفكر وتنقص من قيمته، كما أن الاكتساح التكنولوجي الرقمي والمد المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي قد سبب قلقا للمفكر، الذي يحتاج إلى مسافة زمنية للتأمل. هل يمكن للفكر اليوم أن يعيد لنا الأمل في المستقبل وفي حمايتنا من الضياع والاستلاب والنسيان؟
من المؤكد أن الأحداث التي أشرتِ إليها فرضت على المفكر النقدي مهاما جديدة لاستنهاض ما يحوزه من جاهزية للقيام بما هو مفترض القيام به.
كان “الربيع العربي” فصلا تراجيديا من فصول تفكيك “العالم العربي” وتفجير مُقدراته، والعودة بمجتمعاته إلى “ما قبل الدولة”.
وقد نجحت قوى خارجية وداخلية في إنجاز المهمة، وما تزال تعمل هذه القوى من أجل استكمال فصول المأساة، من خلال التسابق على التطبيع مع من اغتصب الأرض العربية، حتى فاجأ “طوفان الأقصى” الجميع بهدف التذكير بمركزية القضية الفلسطينية وإيقاف مسلسل التطبيع.
لكن سنتين من القتل والدمار، والتجويع، والإبادة، وإن نقلت صورة فلسطين إلى قلب اهتمامات العالم لم تُغير، موضوعيا، من النزوع الواضح في اتجاه القوى التي لا تعمل سوى على إذلال العرب، وتدمير مقدراتهم، وإخضاع الأجساد العربية لكل أشكال التقتيل والمحو، والإهانة والاحتلال.
إزاء هذا الذي حصل ويحصل، وفي ضوء سيادة أنماط جديدة من الاستبداد والحِجر، وداخل مناخ من الضجيج والتشويش، ماذا يملك المفكر من وسائل للقول والتعبير والإنتاج الفكري يسعفه من أن ينتزع لذاته هوامش للتلقي، والتداول، والتأثير؟
نحن أمام تحدٍّ وجودي كبير، سيما وأن العالم أضحى رهينة سلط جديدة سياسية، واقتصادية، وتجارية، وصحية، وعسكرية تتنامى قوتها مع الانتشار الكاسح للتكنولوجيات، الرقمية بالخصوص.
ومهما كانت أشكال الاحتجاجات وطرق التعبير عن مطالبها وأهدافها، فإن الدول أصبحت تحوز ما يتيح لها تكييف “الرأي العام”، وتوجيهه بواسطة مختلف أصناف الإعلام القديم والجديد، والجيوش الإلكترونية المُتَخفية التي أضحت تمتلك قدرات هجومية للتشويش على أي تحرك احتجاجي مهما كان طابعه السلمي أو شرعية المطالب التي يحملها أصحابه.
كما أن السلطات السياسية وبحكم تضايقها مما يمكن أن يحمله المفكرون والمثقفون من نظرات نقدية إزاء السياسات المتبعة، لجأت إلى أنماط متنوعة من الاستشارة و”التقييم” التي ينجزها “خبراء” يقدمونها بوصفها تتوفر على الكفاية العلمية والنزاهة والحياد، واستبعاد المتخصصين في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية الذين، في الغالب الأعم، يكشفون عن تحولات المجتمع بطرق تستحضر المعالجة النقدية، وتكشف عن استراتيجيات الاستخدام والسيطرة والتوجيه التي تتبعها السلط المتحكمة في القرار.
وهكذا، وفي ضوء السطوة الإعلامية للخبراء، وضجيج تقارير “مراكز التفكير” التي تتناسل هنا وهناك، واجتياح التكنولوجيات الرقمية، انسحبت لفظة النقد وتم تعويضها بتقارير ونصوص باردة تدعي تشخيص الأوضاع العربية، وتقيم مؤسسات بلدانها، وتحدد لها سياساتها وقراراتها.
لذلك اعتبرت في كتاب “الزمن المنفلت” أن البشرية دخلت، كما البلدان العربية، في زمن تسود فيه تمظهرات من “العبودية الطوعية”، وتعبيرات متنوعة للضياع، الواعي واللاواعي، لدرجة أن المنظومة الجديدة للوجود التي ولَّدتها الأدوات الرقمية هي بصدد تشكيل بنيات وعي ووجدان جديدين لدى الإنسان.
لقد أضحت هذه الأدوات الرقمية تمثل خطرا داهمًا، ومصدر إرهاق مستدام بالنسبة لمن لم يعد قادرا على خلق المسافة المناسبة مع هذه الأدوات؛ بل وانتقل ما كان يُعتبر تعارضا خارجيا، مع “الحداثة الرابطة”، إلى تعارضات داخلية، لدرجة أن المرء يجد ذاته غارقا في عوالم متموجة تقذف به الخوارزميات في الاتجاهات التي تجعل منه كائنا مُتسكعًا، تائهًا، مُفتقِدًا إلى أي ضابط عقلاني يحثُّه على الانتباه إلى الاستلاب الجارف الذي دخل فيه.
وحتى إن انتفض أحيانا على عبوديته، فإنه نادرا ما يستطيع مقاومة الإغراءات القوية للرقمي وللافتراضي، أو مواجهة آليات الاستبداد والتهديد.
وقفت في كتاباتك ومداخلاتك على مكامن الخلل التي تجعلنا اليوم نتحدث عن الديمقراطية المنقوصة وعن النهضة المُعلقة أو المعطوبة، وعلى رأسها التعليم وغياب الكثير من المبادئ والقيم الكبرى كالحرية والاعتراف والعدالة والاستحقاق والتسامح، فهل هذا يعني أننا في العالم العربي بعيدون كل البعد عن تحقيق النهضة المأمولة؟
صحيح أن العديد من المعاينات جعلتني أصوغها بالسلب أو أصفها بالنقص، اعتبارا لما تكشفه الوقائع من حقائق وممارسات. فهل يجوز لنا ادعاء أننا نعيش في مجتمع سياسي ديمقراطي يُعلي من شأن المواطنة، ويستبعد سياسات الإذلال، ويحد من الفوارق، ويقيم قواعد الإنصاف في المجالات الاجتماعية؟
وهل يمكننا المراهنة على اعتبار نظامنا التعليمي جيدا والحال أن جميع التقارير الوطنية والعربية والدولية تصنفه في ذيل الترتيب العالمي؟ وإلى أي حد يمكننا الحديث عن “نهضة” في الوقت الذي نغض فيه الطرف عن وضعية تراجع المدرسة أو الجامعة العمومية وعن أدوارها في التعليم الجيد والتكوين الناجع وتعريضهما للمضاربة والمنطق الربحي؟
نهضة معلقة وديمقراطية منقوصة
نحن نشهد، موضوعيا، كيف تتعرض الديمقراطية -لفظة، ومفهوما، ونظاما-إلى التشويه والمحاربة؛ ونلاحظ كيف أن العديد ممن يعادونها لا يكفون عن استعمالها، أو عن توظيف آلياتها للوصول إلى الحكم لكي يفرضوا نظاما تحكميًا، وتسلطيًا.
كما أن هناك التباسا كبيرا بين الديمقراطية والليبرالية السياسية، خصوصا وأن أسئلة متجددة تفرض ذاتها عن التمثيلية والحقوق، والرأي العام، أو تطرح على صعيد التحكم في النزاعات، واقتراح أساليب جديدة لتسيير قواعد العقد الاجتماعي.
غير أن المتابع لما يحصل في مجتمعاتنا أن أنظمة الحكم المختلفة تقتبس قاموس الديمقراطية لاستعماله كواجهة لحماية الرأسمال، أو لتبرير الأوتوقراطية، والريع.
هكذا قد تكون الديمقراطية منقوصة حتى في البلدان التي وضعت أسسها المعيارية، واستبطنتها الذهنيات، والمؤسسات، والحياة العامة. فالولايات المتحدة الأمريكية تدوس على حقوق الإنسان والأوفاق الأممية كلما كانت وراء سياساتها مصالح استراتيجية، أو تتورط في الحروب التي لا تكف عن اختلاقها أو تدفع إلى اشتعالها.
كما تشهد الديمقراطية الفرنسية تراجعات واضحة على صعيد حرية التعبير، ومنع التظاهر، وإغلاق وسائل الإعلام أمام تيارات الفكر والرأي بمناسبة الإبادة التي تقترفتها الدولة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
أما غالبية البلدان العربية، فتدخل في إطار “الأنظمة الاستبدادية”. لقد غيَّرت تونس ترتيبها بعد “الثورة” على زين العابدين بن علي ورحيله سنة 2011، عن طريق كتابة دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة إلى أن بلغت الرتبة 82 عالميا، لكننا نعاين كيف دخلت في تراجعات مؤسفة في السنين الأخيرة.
وتمكن المغرب من الخروج من خانة “النظام السلطوي” حيث تم تصنيفه في خانة “النظام الهجين” بحصوله على الرتبة 93، التي وصل إليها بشكل تدريجي.
واعتبارا لهذه المعطيات والمؤشرات، لا مناص من تسمية مناسبة للوقائع وليس للنوايا. نحن نعيش في أوضاع سياسية أكثر من منقوصة، إذا ما احترمنا مؤشرات التصنيف الدولي، وتبقى نهضتنا “مُعلقة” طالما لم نعرف كيف نستثمر في البنيات الأساسية بمقدار ما نستثمر في بناء الإنسان والرأسمال البشري.
وحين يتمكن أصحاب القرار من تغيير التوجهات والاختيارات الكبرى، وينجزوا عمليا ما أعلنوا عنه افتراضيا، وشعر أكبر عدد من الناس بمردودية هذه الاختيارات في عيشهم، وحريتهم، وكرامتهم، وإنسانيتهم حينها يتعين تغيير قاموس الوصف ومعايير التقييم.
صدر لك أخيرا كتاب باللغة الفرنسية بعنوان “ضفاف النظر: لغة بصرية مشتركة في حوض المتوسط” ضمن منشورات مؤسسة “مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط”. كيف يمكن للسينما أن تكون وسيلة مثلى للعبور وتجاوز الخلافات السياسية، وتخلق ما سميتموه بـ “الحساسية المتوسطية في التداول”؟
يتعلق الأمر في هذا الكتاب بإعادة التفكير في البحر الأبيض المتوسط في ظل ما يشهده من متغيرات وتقلبات. وقد عملت على استعراض العديد من المعالجات النظرية والإيديولوجية التي تناولته، ولكن من منطلق البحث عن المسالك المتنوعة التي يبتدعها المتوسطيون وغير المتوسطيين لتكسير الحواجز المختلفة، والسدود المُنتصَبة أمام حركة الأجساد.
السينما.. لغة بصرية عابرة للحدود
ومن بين هذه الوسائط تبرز ما أسميته “لغة بصرية مشتركة” lingua franca visuelle تتمثل في السينما والأدوات السمعية البصرية، متوقفا عند طرق وكيفيات تنظيم شروط عرْضِها، ومُشاهدتها، والتفاعل معها؛ حيث يحرص فاعلون مدنيون، ونخب على جعل “المهرجانات المتوسطية” مِنصَّات وفضاءات للقاء، وكسر الحواجز والحدود، وتنشيط المجالات الترابية والمدن التي تنعقد فيها.
تحفز هذه الأطر الشباب والجمهور على المشاركة، وعلى المشاهدة الذكية للإبداع السينمائي المتوسطي، وتخلق جسور التواصل والتفاعل الفني والثقافي بين مختلف الفعاليات التي تساهم في صنع الأفلام، سواء كانت روائية، قصيرة، وثائقية وغيرها من الإنتاجات البصرية.
لقد تميَّز الفضاء المتوسطي دوما بدرجات متفاوتة من التوتر وتعبيرات العنف والتصادم، حسب السياقات وتوازنات القوى الفاعلة، وهي تعبيرات تُشوش على فرص اللقاء وتُغذي الأحكام المسبقة، وتُعمق مشاعر رفض الآخر.
وعلى الرغم من توافر إرادات التفاعل والتبادل من هذه الجهة أو تلك، يجد المتوسطيون أنفسهم مُعرضين لاحتمالات لا حصر لها من الانسدادات والحواجز لأسباب جيوسياسية، ولعقليات لا تزال مُرتهِنة لمُتخيَّل كولونيالي، ولنزعات تدعو إلى الانغلاق الهوياتي والديني، وما يتمخض عن ذلك من تفكك وإرادة سيطرة.
من هذا المنطلق يَعْرض كتاب “ضفاف النظر؛ لغة بصرية مشتركة في حوض المتوسط” (2025)، لبعض هذه المعطيات ولِما يُشكل وسائل مقاومة لإرادات الاستبعاد، وسياسات الفصل، ومختلف الأسلاك الشائكة التي تضعها الدول أمام حركة الأجساد والأفكار.
ويتناول الكتاب تعبيرات الإنتاج البصري والإبداع السينمائي بشكل أبرز باعتبارها تؤكد، باستمرار، على قدرتها على خلق وسائلها وأساليبها ومسالكها المميزة لتجاوز العوائق والموانع والوصول إلى جمهورها بين ضفتي المتوسط.
وفي هذا السياق، تعرَّضت إلى ما أسميته “الخرائطيات الشعرية” للسينما المتوسطية وتأثير صانعيها على السينما العالمية، بدءا من اكتشاف السينماتوغراف، وتيارات الواقعية، في تعبيراتها الشعرية والجديدة، والسوريالية، والموجة الجديدة، وغيرها من الأساليب وأنماط الحكي التي أنتجها المُتخيَّل السينمائي المتوسطي.
ظهر ذلك، بجلاء، في هجرة مخرجين ذوي الأصول المتوسطية إلى هوليود (مثل مايكل شيمينو، فرانسيس فورد كوبولا، مارتين سكورسيزي، سيرجيو ليوني، إلى كوانتان ترانتينيو وغيرهم من المخرجين والممثلين الكبار ومؤلفي الموسيقى من طراز إينيو موريكوني)، حيث أدخلوا أبعادا جديدة في أفلامهم، وضخُّوا نظرات متجذرة فجروا صورها في شكل أعمال خالدة انتشرت في العالم كافة.
كما ساهمت الهجرة المغاربية إلى أوروبا، والتركية إلى ألمانيا، ومشاركة سينمائيين أوروبيين في أفلام الضفة الجنوبية في انتقال حساسيات وكفاءات متوسطية أنتجت تثاقفًا إبداعيًا متنوع الأشكال والتعبيرات.
أما القسم الثاني من الكتاب، فقد خصَّصْته إلى ما أعتبره إشكالية مركزية في “الثقافات المتوسطية” المتمثلة في الهُوية. وعلى الرغم من المحاولات النظرية التي ادعت تجاوز هذه الإشكالية، يبدو أن الإنتاج السينمائي المتوسطي لا يتوقف عن إبراز تمظهرات الهوية والتغيرات التي تطرأ على طرق التعبير عنها.
ومن أجل الاستدلال على هذا المعطى المتغير التعبيرات، واستمرارية حضوره تناولت جملة أفلام بالعرض والتحليل؛ تونسية، ومغربية، وفرنسية، متوقفا عند المنجز السينمائي ليوسف شاهين ابتداء من فيلم “إسكندرية ليه…؟” إلى “إسكندرية نيويورك”.
فالكتاب لا يكتفي بمساءلة النظرة إلى حوض الأبيض المتوسط في علاقته بالسينما فقط، وإنما يعمل على صياغة فكرية ونقدية للعديد من القضايا النظرية المرتبطة بالهُوية، والمغايرة، والحدود، والإبداع، والمشاهدة، والمسألة البصرية في الثقافة المعاصرة.