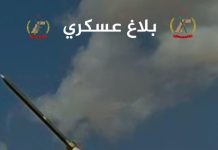محمد مسلم
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. -“الوحدة الترابية” مبرر للقمع السياسي ورفض الإصلاحات والديمقراطية
– النزاع الصحراوي في صدارة الإعلام المغربي والهمّ اليومي على الهامش
– لا ديمقراطية في زمن “الحرب” لرفض النقاش حول العدالة الاجتماعية
يتحدث محمد خوجة، عميد كلية العلوم السياسية سابقا، بجامعة الجزائر، في حوار مع “الشروق”، عن قضية الصحراء الغربية من منظور النظام المغربي والقصر العلوي تحديدا، وكيف حول هذه القضية إلى أداة للتوظيف السياسي، بهدف كسب الشرعية المفقودة، وخلق حالة من الالتفاف الشعبي حول الملك، مقابل صرف أنظار الشعب المغربي المرهق من الفقر والبطالة ورداءة الخدمات الصحية والتعليم، كما يعرج على الدور الدعائي الذي تضطلع به المنظومة الاعلامية في خلق هالة من القداسة على الملك وتنزيهه عن المحاسبة والفشل.
يدعي النظام المغربي أن قضية الصحراء الغربية قضيته الوطنية الأولى، ما مدى صدقية هذا الطرح؟
إن مدى صدقية هذا الادعاء لا يُقاس بحدّة الخطاب، بل بمدى اتساقه مع الممارسات السياسية، والاعتبارات التاريخية، والوظائف التي تخدمها هذه الأولوية داخل النظام المغربي. لا يمكن فهم سياسة المغرب تجاه الصحراء الغربية، بمعزل عن المنطق التاريخي لنظام المخزن، أي السلطة المركزية التي تجمع بين العرش والمؤسسة العسكرية والجهاز الأمني، والذي اعتاد منذ استقلال المغرب سنة 1956، على توظيف القضايا الإقليمية، كقضايا وطنية لخدمة أهداف داخلية.
تقوم ديناميكيات السياسة المغربية، على توظيف القضايا الإقليمية باعتبارها قضايا وطنية، لا بهدف ترسيم الحدود أو استرجاع أراضٍ فحسب، بل كأداة إستراتيجية لتعزيز الشرعية الداخلية، وتصدير الأزمات، وتحويل الانتباه عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
عند استقلال موريتانيا عام 1960، رفض المغرب الاعتراف بها كدولة ذات سيادة، معتبرًا إياها جزءًا من المملكة الشريفة أو المغرب الكبير، مستندًا إلى روابط تاريخية وثقافية ودينية مع القبائل الصحراوية، الممتدة من جنوب المغرب إلى نهر السنغال. وفي عام 1963، بلغ التصعيد ذروته حين قدّم المغرب طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة للمطالبة بأراضٍ موريتانية، خاصة في الشمال، مما أدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الحدود بين البلدين، ولو بحثنا في الوقائع التاريخية سنجد أن هذا الموقف، لم يكن محكومًا فقط بحسابات جغرافية أو تاريخية، بل كان يخدم وظيفة داخلية واضحة. ففي تلك الفترة، كان المغرب يعاني من توترات سياسية واجتماعية حادة: معارضة نشطة من قبيل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والاشتراكيين والإسلاميين، واحتجاجات شعبية، وبداية الانقلابات العسكرية الفاشلة.
وفي هذا السياق، شكّل العدو الخارجي، سواء فرنسا التي دعمت موريتانيا أو الانفصال المفتعل كما كان يسمى في الإعلام المخزني أنذاك، ذريعة مثالية للنظام كي يوحّد النخب السياسية والاجتماعية حول شعار الوحدة الترابية، ويبرّر القمع السياسي باسم الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويؤجّل أي إصلاحات ديمقراطية تحت شعار التهديدات الخارجية.
ولم يعترف المغرب رسميًا بموريتانيا إلا عام 1969، بعد ضغوط دولية وتحولات إقليمية، وبروز أولويات جديدة. ومع ذلك، ظل الخطاب الرسمي يحتفظ بنبرة الوحدة الثقافية بين الشعبين، متجنّبًا الاعتراف الكامل بالسيادة الموريتانية كواقع تاريخي مستقل. وهكذا، تحولت قضية موريتانيا من نزاع حدودي، إلى أداة سياسية داخلية لتأجيل الأزمات وتوحيد النخب، حول مشروع مركزي لا يُناقش.
وبعد استقلال الجزائر اعتبر المغرب، أن الحدود التي وضعتها فرنسا بين مستعمرتيها باطلة، لأنها لا تعكس الروابط التاريخية بين القبائل. وسرعان ما تحول إلى اعتداء غادر على الجزائر سنة 1963، مسجلا بذلك أول نزاع مسلح بين دولتين عربيتين بعد الاستقلال.
واستُخدم المخزن هذا النزاع داخليًا بكثافة لخدمة أجندة النظام: لتبرير التضخم العسكري وزيادة الميزانية الدفاعية، ولقمع المعارضة، خصوصًا اليسار والقوميين العرب، بتهمة العمالة للجزائر، ولتعزيز صورة الملك باعتباره حامي الوحدة الترابية، في مواجهة الانفصاليين، وسرعان ما أصبحت الجزائر في قلب الخطاب المغربي رمزًا للتدخل الخارجي، خاصة بعد دعمها لجبهة البوليساريو لاحقًا.
وحتى حين وُجد حل دبلوماسي، كما في اتفاقية إفران عام 1972، فإن الملك الحسن الثاني رفض المصادقة عليها، بحجة الظروف الداخلية. لكن السبب الحقيقي هو أن العداء مع الجزائر، كان أكثر فائدة سياسيًا داخليًا من حله، فبقاء النزاع مفتوحًا كان يخدم وظيفة تجميعية وشرعية، لا يمكن أن يوفّرها السلام.
هناك من يعتقد في المعارضة المغربية، أن القصر جعل من قضية الصحراء الغربية، مسوغا لتحويل انشغالات الشعب المغربي وصرف أنظاره، عن مشاكله الحقيقية المتمثلة في الفقر والبطالة، ما قولكم؟
يمكن الجزم أن الصحراء الغربية هي ذروة التوظيف السياسي للمخزن المغربي، فمنذ عام 1975، تحولت هذه القضية إلى مصدر رئيسي لشرعية العرش، تحت شعار الملك يدافع عن التراب الوطني، واستخدم هذا الشعار لسياسات قمع كل صوت نقدي، إذ يُتهم من ينتقد سياسة الصحراء بالخيانة، وإلى وسيلة لتأجيل الإصلاحات، تحت شعارات مثل: لا ديمقراطية في زمن الحرب، ولا نقاش حول الوحدة الترابية.
وقد استمر هذا النمط حتى في العقود الأخيرة. ففي فترات الأزمات الاقتصادية كأزمة الثمانينيات، أو احتجاجات الحسيمة عام 2017، أو الحراك الاجتماعي عام 2020، يُعاد إطلاق الخطاب الوحدوي لتحويل النقاش من مطالبه بالخبز والحرية إلى شعارات الوحدة والسيادة. ففي عام 2020، على سبيل المثال، وبعد جائحة كورونا وانكماش اقتصادي حاد، ركّز الإعلام الرسمي على الانتصارات الدبلوماسية في الصحراء، مثل اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية، كوسيلة لصرف الانتباه عن تدهور الأوضاع المعيشية.
يعتمد المخزن على آليات منتظمة لتوظيف القضايا الخارجية داخليًا، تتمثّل في صناعة العدو سواء كان فرنسا أو الجزائر أو جبهة البوليساريو، أو اللوبي الانفصالي، وتسطيح النقاش: أي نقد للسياسة الخارجية يُحوّل تلقائيًا إلى خيانة وطنية، والاستثمار الرمزي عبر المسيرات، خطابات العرش، الاحتفالات الوطنية، التي تعيد إنتاج قدسية القضية الوطنية، والتحالف مع النخب، إذ تُشرك الأحزاب، الإعلام، المؤسسات الدينية في هذا الخطاب، مقابل حصصها من السلطة أو الموارد.
إن سياسات المخزن لم تنظر يومًا إلى القضايا الإقليمية، كمسائل جغرافية أو قانونية بحتة، بل كأدوات لبقاء نظام الحكم الملكي، الذي لا يحارب من أجل الأرض، بل من أجل استمرار نفسه. وكلما اشتدت الأزمات الداخلية كالبطالة وانتشار الفساد والتفاوت الاجتماعي، زادت وتيرة الخطاب الوحدوي والترابي، ليس لأن الأرض مهددة، بل لأن النظام يحتاج إلى عدو ليبرر وجوده.
وبهذا المعنى، فإن مطالب المغرب في الصحراء الغربية أو موريتانيا أو مع الجزائر، هي ملفات وظيفية، تخدم أولويات نظام المخزن وإستراتيجيته في البقاء عبر عدو خارجي، ولا علاقة لها بمصالح الشعب أو الاستقرار الإقليمي، وقد عبر عنها المؤرخ المغربي عبد الله العروي، والذي اعتبره أحد أبرز المثقفين النقديين في المغرب والعالم العربي، ببصيرة نادرة، قال: الوحدة الترابية في المغرب لم تكن يومًا مجرد خارطة جغرافية، بل كانت دائمًا خارطة للسلطة.
ما الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الرسمية في تضخيم قضية الصحراء الغربية مقارنة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية؟
تساهم وسائل الإعلام الرسمية في المغرب بدور محوري في تضخيم قضية الصحراء الغربية، وتقديمها باعتبارها القضية الوطنية الأولى، في مقابل تهميش أو تسطيح القضايا الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، التي تمسّ حياة المواطنين اليومية. ويتم ذلك عبر آليات متعددة تخدم، في جوهرها، أجندة النظام السياسي، أكثر من خدمة المصلحة العامة أو تطلعات المجتمع.
يقوم الخط الافتتاحي للإعلام المخزني على الأولوية التحريرية: الصحراء في الصدارة، والهمّ اليومي في الهامش، وتُخصّص وسائل الإعلام الرسمية كالقناة الأولى، وكالة المغرب العربي للأنباء، الإذاعة الوطنية، حصصًا زمنية كبيرة لتغطية كل حدث مرتبط بالصحراء الغربية والجزائر، مهما كانت قيمة الحدث: توظيف التصريحات الدبلوماسية، تحويل زيارات الملك المغربي أو وزير الخارجية، إلى انتصارات إعلامية في المحافل الدولية.
وفي المقابل، تُعالج القضايا الاجتماعية والاقتصادية كالبطالة وغلاء المعيشة والفساد وأزمة التعليم، أو نقص الخدمات الصحية، بشكل جزئي أو استثنائي وغالبًا عند اندلاع احتجاجات، ثم تُعاد إلى الخلفية بمجرد انحسار التوتر.
في سنة 2020، خصّصت القنوات الرسمية ساعات طويلة، لتغطية اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما غطّت أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية أو انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل سطحي أو متأخر.
تستخدم وسائل الإعلام الرسمية المخزنية لغة تعبوية، تخلط بين الوطنية والولاء للنظام: فكل من يدافع عن وحدة التراب يُقدّم كبطل وطني، وكل من ينتقد سياسة الدولة في الصحراء الغربية، حتى لو كان يطالب بحلول سلمية أو حقوق إنسان، يُوصَف بالخائن والعميل.
وهذا الخطاب لا يُفسح مجالًا للنقاش العقلاني، بل يُحوّل القضية إلى مسألة إيمانية أو وجودية، لا مجال فيها للتساؤل أو التنوّع في الرأي.
تُصوّر وسائل الإعلام الرسمية الملك، باعتباره حامي الوحدة الترابية، وتُقدّم كل زيارة ملكية إلى مدن الصحراء الغربية المحتلة كحدث تاريخي، يعيد سردية تأكيد السيادة، بينما تُهمَل الزيارات إلى مناطق تعاني من الإقصاء الاجتماعي، كجبال الأطلس أو الريف أو تُعرض كمبادرات خيرية فردية، لا كاستجابة لحقوق مدنية واقتصادية.
وهكذا، يصبح الاهتمام بالصحراء الغربية رمزًا للشرعية، بينما يُنظر إلى معالجة الفقر أو البطالة كأعمال إحسان، لا كواجب دستوري.
وتُؤطَر قضية الصحراء الغربية دائمًا في سياق الصراع مع العدو الخارجي: الجزائر، البوليساريو، مما يعزّز شعور التهديد الجماعي ويبرّر التضامن مع نظام المخزن. أما القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فالإعلام المخزني يغطيها غالبًا، كـأزمات فردية أو ظرفية: غلاء عالمي، جائحة استثنائية، لا كنتائج لاختيارات سياسية أو فشل في الحوكمة. وهكذا، يُحوّل الإعلام المسؤولية من الدولة إلى الظروف.
وحتى وسائل الإعلام الخاصة التي تعتمد على الإعلانات الحكومية، أو تمويل رجال الأعمال المقربين من المخزن، تمارس رقابة ذاتية وتتفادى طرح أسئلة جريئة حول الصحراء الغربية، أو ربطها بالفساد أو توزيع الثروة، في المقابل، تُفتح المنصات للخبراء والمحللين الذين يروّجون للرؤية الرسمية، بينما يُهمَش الباحثون المستقلون أو النشطاء الحقوقيون.
يمكن القول إن وسائل الإعلام في المغرب تضطلع بدور الدرع الأيديولوجي للنظام، لا كمرآة عاكسة للمجتمع.
فهي تُشكّل الوعي وتُوجّه الأولويات، وتُعيد تعريف ما هو الوطني، ليتمحور حول الولاء للتراب، لا حول العدالة الاجتماعية أو الكرامة الإنسانية. لا تُهمّش القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لأنها أقل أهمية، بل لأن معالجتها بصدق قد تكشف عن فشل بنيوي في نموذج الحكم، بينما تُضخّم قضية الصحراء الغربية، لأنها تُغطّي هذا الفشل برداء البطولة الوطنية.
يحلّل عبد الله العروي كيف تُوظّف الدولة المغربية مفاهيم مثل الوحدة الترابية والثوابت الوطنية، لتعويض غياب المشروع التنموي والديمقراطي، وكيف يُستخدم الخطاب الوطني كأداة لتغطية الفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية. وبمرور الوقت، تبنّى نشطاء وكتّاب مغاربة هذه الفكرة وصاغوها في جملة سريعة وقوية تلخّص نقدًا عميقًا للخطاب الإعلامي المخزني: عندما يعجز النظام عن إطعام الشعب، يُطعمه خطابًا عن التراب.
وهي اليوم جزء من الذاكرة النقدية الجماعية في المغرب، تُستخدم لوصف سياسة الخبز مقابل الخطاب، التي يعتمدها نظام المخزن، عند تعثّره في تلبية الحاجات المادية والاجتماعية للمواطنين.
كيف يؤثر التركيز السياسي والإعلامي على الصحراء الغربية، في تهميش النقاش العمومي حول العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية؟
في تحليل السياسة الخارجية المغربية، أول ما يلاحظ، هو التركيز السياسي والإعلامي المفرط على قضية الصحراء الغربية، تحولها كأولوية في السياسة الخارجية، إلى آلية هيكلية لتهميش النقاش العمومي، حول العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. ويتم ذلك عبر منظومة مترابطة من الخطاب والتوجيه المؤسسي، وضبط الحدود المسموح بها للنقاش العام.
وفيما يلي تحليل لأهم آليات هذا التأثير: بتحويل الوطني إلى الترابي على حساب الاجتماعي، يُعاد تعريف مفهوم القضية الوطنية في الخطاب الرسمي، ليتمحور حصريا حول الوحدة الترابية، بينما تنزاح القضايا الاجتماعية، كالعدالة في توزيع الثروة، الحق في التعليم والصحة، أو مكافحة الفساد من دائرة الأولويات الوطنية، إلى حيّز التفاصيل التقنية أو المطالب الفئوية، وأي مطالبة بالعدالة الاجتماعية تُنظر إليه، باعتبارها انقساما داخليا قد يُضعف الجبهة الداخلية في مواجهة العدو الخارجي. وحتى عندما تندلع احتجاجات ضد غلاء المعيشة أو البطالة، يُسارع الخطاب الرسمي إلى اتهام أطراف خارجية بتأجيجها، بدلًا من معالجة جذورها الاقتصادية.
كما يتم التعامل مع قضية الصحراء باعتبارها من الثوابت التي لا تُناقش، مما يُرسّخ ثقافة سياسية ترفض التعدّد في الرأي حول القضايا الجوهرية. وينتقل هذا المنطق تلقائيا إلى باقي المجالات، فإذا كان الحديث عن تقرير المصير أو حقوق الإنسان في الصحراء خيانة، فكيف يُمكن مناقشة سياسات التقاعد، أو إصلاح التعليم، أو العدالة الضريبية بحرية؟ بل سيصبح الاختلاف السياسي موضع شكّ أخلاقي، لا خيارًا ديمقراطيا مشروعًا.
وهكذا، يُبنى مناخ عام من الرقابة الذاتية، حيث يتجنّب المواطنون والفاعلون المدنيون، طرح أسئلة جريئة خشية التهميش أو التجريم.
ويتم توجيه الموارد الرمزية والمادية بعيدًا عن التنمية الشاملة، والتركيز على الصحراء الغربية لا يقتصر على الخطاب، بل يمتد إلى تخصيص الموارد. فالمشاريع التنموية الكبرى كالمطارات، الموانئ والطرق، تُركّز في الصحراء الغربية كـإثبات على السيادة، بينما تُهمَل مناطق أخرى تعاني من الإقصاء المزمن كالريف والأطلس والجنوب الشرقي.
كما يوظف الإعلام كجهاز توجيه أولويات الجمهور، وتخصيص مساحات كبيرة لتغطية كل حدث مرتبط بالصحراء الغربية، بينما تُعالج القضايا الاجتماعية بشكل سطحي أو استثنائي.
وهذه التغطية غير المتوازنة تساهم في إعادة تشكيل إدراك الجمهور، فالمواطن يُقنَع بأن الخطر الحقيقي قادم من الخارج، الجزائر، البوليساريو، لا من داخل منظومة تُولّد الفقر، التفاوت، الاستبعاد، ويُصبح النقاش حول كيف نُوزّع الثروة؟ أو كيف نُحقّق العدالة الضريبية؟ هامشيا مقارنة بـكيفية الدفاع عن التراب؟
يظهر تحليل المحتوى للخطاب الرسمي المغربي، أن موضوع الصحراء الغربية يقدم كأزمة وجودية للمخزن، تتطلب توحيد الصفوف وتأجيل الخلافات الداخلية، ويُستخدم كذريعة دائمة لـتأجيل الإصلاحات الديمقراطية، وتقييد الحريات النقابية والسياسية، وتبرير غياب الشفافية في تدبير الموارد. ويوظف شعار لا ديمقراطية في زمن الحرب، والمقصود هنا الحرب الدبلوماسية، لتجميد النقاش حول العدالة الاجتماعية، باعتباره ثانوي لا يليق بلحظة التحدي الوطني.
إن التركيز المفرط على الصحراء الغربية، لا يُهمش فقط قضايا العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في المغرب، بل يُلغِي شرعيتها كأولويات وطنية. ففي حين يُحتفى بكل انتصار دبلوماسي حول موضوع الصحراء الغربية كحدث تاريخي، تُقابل مطالب المواطنين بالكرامة، الشغل، الخدمات الأساسية بخطاب تقني جاف أو صمت مطبق.
وهكذا، يُحوّل النظام، الصراع من الداخل إلى الخارج، بدل مواجهة الفساد المنتشر والتفاوت الاجتماعي المتسارع، وفشل النموذج التنموي، يُقدّم للشعب عدوّا خارجيا ليُوحّد حوله، حتى لو كان الثمن إجهاض النقاش الديمقراطي وتجميد مطلب العدالة الاجتماعية.
السؤال الذي يطرحه المواطن المغربي، عقب الاحتجاجات الشعبية المتجددة، كيف يمكن لدولة أن تبني سيادتها الحقيقية على أراض قبلت أن تتفاوض على مصيرها ولا تزال مطروحة في الأمم المتحدة، كقضية تصفية الاستعمار، بينما تُهدر كرامة مواطنيها في الداخل؟ السيادة الحقيقية لا تُقاس بمدى اتساع الخارطة، بل بمستوى العدالة والحرية والكرامة التي يعيشها الشعب.
المصدر: الشروق أونلاين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس