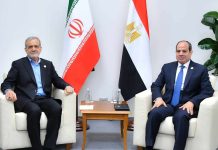عديد نصّار
أفريقيا برس – مصر. كثيرا ما يردّد بعضهم، سواء في مصر أو في سواها من البلاد العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة، خطابات من نوع: ماذا قدّمت الثورات والانتفاضات الشعبية لتلك البلدان ولتلك الشعوب؟ هل تغيّرت أحوالُها نحو الأفضل، أم كما نراها اليوم باتت في أسوأ مما كانت عليه قبل تلك الثورات والانتفاضات. انظروا إلى سورية.. إلى اليمن.. إلى مصر.. وحتى تونس التي قيل إنها تجنّبت ما أصاب سواها من حروب واضطرابات دموية كيف تتخبّط وما هو حال أبنائها.
هذا الخطاب وأمثاله الذي تبثّه أدوات الأنظمة، ويردّده خلفها الغوغاء والحمقى والمأجورون كي تقول للشعوب إنها ستواجه الكوارث والخراب (مصير سورية، مصير اليمن …) في حال انتفضت وثارت على ما قادتها إليه تلك الأنظمة من انهيارات وتأخّر ونهب ونسف للمقدّرات والإمكانات وتدمير للقطاعات المنتجة وفرص العمل، وصولا إلى حافّة الجوع، بل إلى المجاعة نفسها، وفوقها القهر والإذلال، يؤشر هذا الخطاب إلى: أن السياسات المتواصلة المتبعة من هذه الأنظمة ستفضي إلى الانتفاضة والثورة، وهو اعتراف غير مباشر بجرائمية هذه السياسات. وأن الأنظمة وملحقاتها باتت تعيش قلقا دائما بعد موجات الانتفاضات والثورات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في البلاد العربية من أقصى المغرب إلى البحرين. ثالثا والأهم، يقفز هذا الخطاب، أو يراد منه القفز، فوق الأسباب المادية التي تدفع الشعوب إلى الثورة، فحيث تتساوى لدى شعبٍ ما احتمالات الموت جوعا وقهرا مع احتمالات الموت على أيدي أدوات القمع، لا شيء يمكن أن يقف في وجه احتمالات الثورة، مهما كانت نتائجها المباشرة.
من هنا، ينبغي للبحث العلمي أن ينطلق من الأسباب المادّية التي بنتيجتها تتراكم الضغوط على القيعان الاجتماعية، وصولا إلى مرحلة الانفجار الكبير. فما هي الأسباب المادّية التي فجرت ثورة 25 يناير (2011) في مصر، والتي نعيش اليوم أجواء ذكراها الثانية عشرة؟ وهل تمكّنت الدولة العميقة في مصر من الإجهاز تماما عليها بعد كل هذه السنين؟
منذ أطلق الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، سياسة الانفتاح الاقتصادي في سبعينات القرن الماضي، بدأت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين المصريين بالتراجع، نتيجة مباشرة للإهمال المتعمّد والمتمادي لقطاعات الإنتاج الرئيسية التشغيلية، وفي طليعتها الصناعة والزراعة، إفساحا في المجال لكبار الرأسماليين للاستثمار في قطاعي الاستيراد والتجارة. ( نتذكّر هنا قصة القطط السمان، الاسم الذي أُطلق في حينه على كبار التجار والمحتكرين المحظيين من النظام والذين تبادلوا المنافع مع أركانه)، فكانت النتيجة أن ارتفعت، بنسب كبيرة، أسعار مختلف السلع الاستهلاكية الأساسية، ومنها الخبز ما أدّى إلى انتفاضة 18 و19 يناير 1977 التي ووجهت بالقمع ومحاولات التشويه التي كان في صدارة مطلقيها أنور السادات نفسه، حين أطلق عليها اسم “انتفاضة الحرامية”.
وكان إهمال القطاع العام المنتج والامتناع عن تطوير مصانعه وتجهيزاته قد مثّل أولى انتكاسات الاقتصاد التشغيلي في مصر الذي تراجعت قدراته الإنتاجية ومردوديته، في محاولة لبيعه والتخلّص منه، قد تواصلا في عهد الرئيس حسني مبارك، ما أوصل إلى تراجع كبير في مستوى معيشة العمال والموظفين، الأمر الذي أدّى الى حركات احتجاجية متكرّرة لعمّال مصانع القطاع العام، وخصوصا عمّال مصنع غزل المحلة وسواهم، وصولا إلى إضرابات 6 أبريل/ نيسان 2008 التي شملت إلى عمّال مصنع المحلّة مراكز إنتاجية ومؤسسات عديدة في كل مصر تلبية لدعوة شباب حركة 6 أبريل الذين كانوا قد أعدّوا لهذا الحراك الذي ووجه بالقمع البوليسي، وسقط فيه ضحايا واعتقل آخرون.
كان لتراجع القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل أثرٌ بالغ على العمالة المصرية، فارتفعت نسب البطالة بين الشباب الذين آثر مئات الألوف منهم الهجرة والعمل في الخارج. وكان العراق وجهة أساسية للعمالة المصرية في ثمانينات القرن الماضي، حين كان المجهود الحربي للعراق يستنزف شبابه وقواه التشغيلية، ما مكّن مئات آلاف المصريين من أن يجدوا فرص عمل متنوّعة في العراق. لكن ما حدث للعراق بعد غزو الكويت وحرب عاصفة الصحراء (تحرير الكويت) ثم الحصار المديد تسبّب بكوارث ومآسٍ طاولت العمّال المصريين هناك.
وإذا كانت دول الخليج العربي تمثل وجهة أخرى ولاحقة للعمالة المصرية، فإن تمييزا كبيرا لحق بالمصريين في بعضها، أوجد معاناة إضافية دفعت كثيرين إلى إعادة النظر والعودة الى مصر. وقد مثلت كل هذه الضغوط السبب المادي الرئيس في تفاقم النقمة على نظام حسني مبارك وحزبه، وعلى الطبقة السياسية المتحكّمة بالاقتصاد المصري ومعيشة الشعب ومستقبله.
إلى جانب العوامل الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة التي دفعت دوائر إضافية من المجتمع المصري إلى الانضمام إلى دائرة الفقر والتهميش، كان انسداد الأفق السياسي أمام المصريين قد بدأ يظهر أكثر سُمكا وقتامة، حين بدأت الطبقة السياسية الحاكمة تروّج لخلافة جمال مبارك أباه في رئاسة مصر. ترافق ذلك مع حملات قمع واسعة للمعارضين والقوى الداعية إلى التغيير، وفي مقدّمتهم ناشطو حركة 6 أبريل وقيادات الحركة المصرية للتغيير (كفاية).
صحيحٌ أن دورا بارزا لثورة 17 ديسمبر التونسية، ولنتيجتها المباشرة التي تجلّت انتصارا مبدئيا، ولكن فريدا، في فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وسقوط نظامه في 14 فبراير 2011 في تشجيع المصريين على الانتفاض، (التوانسة موش أجدع مننا، تونس مش أجدع من مصر..) ( في الواقع لقد بدأت تنتشر الدعوات إلى الثورة في 25 يناير في الوقت نفسه الذي أعلن فيه عن فرار زين العابدين). كانت الشرارة التي عصفت باحتقان مزمن لدى المصريين زاد توتّرا بعد حادثة مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة (6 يونيو/ حزيران 2010) وبعد حادثة تفجير كنسية القدّيسين في الإسكندرية (فجر الأول من يناير/ كانون الثاني 2011)، إلا أن الأسباب المادية الحقيقية لانتفاضة 25 يناير تكمن في تفاقم الأوضاع المعيشية للطبقات الدنيا التي توسّعت على مدى عقود، مضافا إليه العامل السياسي الذي تبدّى بانسداد أفق التغيير الديمقراطي السلس، وما ترافق معه من قمع ومنع واحتقار لقوى التغيير، وفي مقدّمتهم شباب مصر وعمّالها وفلاحوها. وهكذا تضافرت عوامل الاستجابة الواسعة والجريئة والاندفاعة الكبرى للشعب المصري يوم 25 يناير 2011 وما بعده.
ولئن مثلت عائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحكومته والدوائر المقرّبة في الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) الواجهة السياسية للنظام، فإن كبار المستشارين والقادة العسكريين والمؤسسات الاستثمارية للجيش وسواه، وكبار المتموّلين والتجار ودوائرهم، تجسّدت فيهم دوائر الدولة العميقة مسلحةً بشبكات وأدوات أمنية وقضائية وإعلامية وثقافية داعمة. وقد لوحظ منذ اليوم الأول للثورة تورّط كامل للأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين وقمعهم بكل الطرق، بما فيها إطلاق النار الحي المباشر، واستخدام البلطجية والمجرمين الذين أطلقوا من السجون بشريطة قمع المتظاهرين والتعدّي عليهم، ولوزارة الداخلية المصرية باع طويل في هذه الأمور، بينما وقف الجيش على الحياد يراقب عن كثب ولا يتدخّل. وكما كان هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام” شعلة الثورة ومُحشّدها، كان إطلاق هتاف “الجيش والشعب إيد واحدة” بداية المشوار في عملية إجهاض الثورة تلته مباشرة عملية تنحية مبارك واستلام المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011.
تلا ذلك جرّ المصريين تكرارا إلى صناديق الاقتراع في استفتاءات وانتخابات متتالية على مدى سنتي 2011 و2012 في مخادعة ديمقراطية، انتهت إلى فوز محمد مرسي من حزب الحرية والعدالة (إخوان مسلمون) بمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن كان حزبه قد فاز أيضا متقدّما عن سواه في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وتخللت السنتين كما تخلل العام الذي تولى فيه مرسي منصب الرئاسة أحداث جسام ( تفجيرات إرهابية وحوادث مفجعة ومجازر دموية: ماسبيرو، حرق مقرّات، أحداث سيناء .. حوادث الإخفاء القسري للناشطين)، وكانت تبعاتها تُعلّق إما على الإرهاب أو على خارجين على القانون.
كان من أبرز النتائج المباشرة لثورة 25 يناير، وفي عزّ اندلاعها، انكشافُ دور وزارة الداخلية والشبكات التي شكلها الوزير حبيب العادلي في تفجير كنيسة القدّيسين. وهذه قد تكون قرينة تؤشّر إلى أن مثل هذه الشبكات، الملحقة سواء بوزارة الداخلية أو بأجهزة الحزب الحاكم، أو بقادة بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية، ربما تكون خلف كل هذا المسلسل من أعمال العنف التي أريد منه تشويه ثورة 25 يناير، وتسهيل الانقضاض على ناشطيها البارزين.
ولم يكن تسهيل وصول حزب الحرية والعدالة (إخوان مسلمون) من المجلس العسكري إلى السلطة في أعقاب الثورة إلا تمهيدا لشيطنة “الإخوان” وأخونة الثورة ثم التخلص منهما على يد العسكر. وتمكن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من ركوب موجات الاحتجاج على حكم الإخوان والانقلاب على الديمقراطية الشكلية التي خدعوا بها المصريين. ولم ينته الأمر هنا، فقد تلاحقت جرائم العسكر من اعتقال مرسي إلى مذبحة ميدان رابعة العدوية إلى ملاحقة كل فاعليات ثورة 25 يناير ومحاكمتهم واعتقالهم والعمل على تشويه صورتهم، ثم اعتقال كل من تسوّل له نفسُه الترشّح لانتخابات الرئاسة في وجه السيسي. وفي وقت جرت فيه تبرئة رموز النظام السابق، قُتل الرئيس المنتخب محمد مرسي بالإهمال الطبي في أثناء اعتقاله، ولا يزال عبد المنعم أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي في معتقله، بعد أن أُخضع لمحاكمة صورية. أمّا من تبقوا من ناشطي 25 يناير أو من بقي منهم في مصر، فلا يزالون قيد الملاحقة أو الاعتقال، منهم علاء عبد الفتاح وماهينور المصري التي أطلق سراحها قبل أشهر، بعد محاكمة صورية وسنوات من الملاحقة والاعتقال.
بعد 12 عاما، وفي ظاهر الأمر، استعادت الدولة العميقة بواسطة العسكر سطوتها ما قبل “25 يناير”. وضعت يدها على الإعلام، أمسكت بقوت المصريين بشدّة، (انهيار العملة الوطنية) محاولات لاستقطاب فئات طفيلية تُمجّد السلطة في عزّ ارتكاباتها بحقّ الجغرافيا والحدود (قضية جزيرتي تيران وصنافير) والاقتصاد والخدمات الأساسية، تمجيد عمليات القمع المتواصلة بحقّ الفئات المهمَّشة والإصرار على تشويه ثورة يناير.
ويشي هذا كله بأنّ العوامل التي دفعت المصريين إلى الانتفاض والثورة تضاعفت، وأنّ احتمالات عودة 25 يناير من إجازتها القسرية المديدة تتزايد، فمصر التي تصبر على الضيم لا تصبر على القهر. وإن غدا لناظره قريب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس