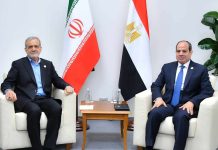ضايا
أحمد بسيوني
أفريقيا برس – مصر. عاش الإسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي تحدّياتٍ واجهت استمراريته حزبا أولًا، وتجربة ديمقراطيّة ثانيًا، ومع تصاعد نجم أحزاب الإسلام السياسي، باعتبارها مُخرجات ثورات الربيع العربي، ليس كأساسٍ وجودِيّ، وإنّما بروزهم من أجل ديمقراطيّة مقبلة، أي إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، وإشراك الأحزاب في العمليّة الديمقراطيّة، كما شهدنا في الحالتين، التونسيّة والمصريّة، من أجل العبور عبر التحدّيات المؤسساتيّة، إلى ديمقراطيّة الدّولة، تبدأ بالسّماح لحركات الإسلام السياسي المشاركة السياسيّة، إلّا أنّ هذه الأحزاب واجهت السقوط والفشل، ولكن لأسبابٍ متباينة. كان الهدف من الثورات، وانتخاب نجم الإسلاميين وصعوده، هو تطبيق الحريّة/ الديمقراطيّة، والعدالة الاجتماعيّة/ التوزيع العادل للثروات والفرص، وتحرير الإرادة الوطنيّة من الهيمنة الدوليّة، أي إعادة بناء دولة وطنيّة بنُخبٍ جديدة، وهنا السؤال الذي يصاعد لنا، ما مدى قدرة الإسلاميين على تجسيد الدّولة الوطنيّة؟
في خضمّ الفشل الهيكلي للدّولة في أداء وظائفها، كالفشل المؤسّساتي الذي رفض إدماج أحزاب سياسيّة في عمليّة بناء القرار السياسي، ومدى وجود مفهوم “الدولة العميقة” وتغلغله في المؤسسات التابعة الدّولة، وتفاعل القوى الفاعلة غير المُنتَخبة في التأثير على اكتمال إدماج حركات الإسلام السياسي في مؤسسات الدّولة. وإنْ كان هنالك فشل لا يتحمّله الإسلام السياسي، وإنّما أيضًا تتحمّله، بدرجة أولى، الدّولة العربيّة، لأنّها عملت على وقف التحوّلين، الليبرالي والديمقراطي، عبر مجموعة من السلوكيّات الاستبداديّة والعنف المُفرَط. ويعود سبب ذلك إلى معاناة الدّولة العربيّة من فشلٍ مؤسساتي لا يُتيح للإسلام السياسي الاندماج، وليس هذا الفشل فقط امتدادًا لبناء الدّولة العربيّة بعد الاستعمار، وإنّما هو فشل اختياري، توجّهت “البيروقراطيّة” العربيّة نحوه، وثبّتته. لذلك لا يمكننا الحديث عن عدم جهوزيّة حركات الإسلام السياسي فقط، وإنّما وجود مشكلات بنائيّة ترتّب عليه عدم توازن في وظائف الدّولة. وعليه، كانت النتيجة انفجار هذا الخلل في خِضم وجود حركات الإسلام السياسي في السّلطة.
مصر، تونس، المغرب
تطرّق باحثون عديدون للحالة المصريّة، من أجلِ وصف طبيعة النّظام الذي يتفاعل مع المجتمع، حيث يرى ويليام تايلور في الدّولة المصريّة رؤية عسكريّة، والمتمثِّلة في تدخّل الجيش في الحياة السياسية، ربطها بالهويّة الثقافيّة للعسكري، والمصالح الشخصيّة والعسكريّة، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات السياسيّة، وحجم المؤسّسة العسكريّة. وبما أنّ الحركة الديمقراطيّة في الدّولة المصريّة فشلت بسبب الأدوار غير الفاعلة في الدولة، علاوةً على ذلك، الأيديولوجيّة الدينية وفشلها في ضمّ الشارع لها، أتاح للمؤسّسة العسكريّة المصريّة أداء دورٍ سياسي وكسب تأييدٍ شعبيّ، بصفتهم “مشروعا وحيدا قابلا للتحقيق”، وهذا ما جاء نقيضًا لما ذكره صموئيل هنتغتون، عندما دعا إلى تطبيق نظام “الرقابة الحياديّة”، والتي تعني فصل الحكم المدني والممارسة العسكريّة، أي يجب على القادة السياسيين تحديد الهدف من وجود العسكر، وألّا يتدخّل المدني في تفاصيل عمل العسكري، وكذلك يبقى العسكري بعيدًا عن السياسية، ويبقى دوره مهنيًا لا سياسيًا. لكن في ظلِّ الامتيازات الكبيرة التي حظي بها الجيش المصري تراكميًا عبر السنوات، وقدرته على الحفاظ على مهنيّته ومصالحه، بقيَ بعيدًا عن ثورة 25 يناير (2011)، ولم يتدخّل إلّا عندما شعر بأنّ الثورة ستؤثِّر على مصالِحه وأجبر مبارك على التنحّي. في السياق نفسه، تدخّل مرّةً أخرى لتنحيّة الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، مستغلِّا المظاهرات التي جابت الشوارع ضدّ حكم “الإسلام السياسي”، وبالتّالي وُصِف هذا التدخّل بانقلابٍ عسكريّ. وأصبح الآن دوْر الجيش المصري حماية النظام، بعد أن وضعَ نفسه في خانة الحَكَم على الثورات[1]. ذهبت دراسات أخرى إلى تفسير أسباب خسارة “الإخوان” حكم مصر، على الصّعيد الاجتماعي، يعود إلى خسارة الإخوان المسلمين أهم فئتين اجتماعيتين، طبقة الفقراء، والطّبقة الوسطى، وأيضًا إلى أدْلجة الدولة المصريّة، أي إقامة دولة الحزب على أساسٍ أيديولوجي في المستويات الوسطية من البيروقراطيّة المصريّة التَّليدة، بالإضافة إلى تهميش دور المرأة في المجتمع.
وعلى الصّعيد السياسيّ، ذهبت إلى التوقّعات الشعبيّة التي صاحبت الغليان الثوري للمجتمع المصري، وتحدّيات الإسلام السياسي بعدما وصل إلى الحكم، ومحاولته إنقاذ الدّولة المصريّة من الانهيار الذي وصلت إليه بفعل حكم الرئيس حسني مبارك، وعلى البرنامج الاقتصادي للإخوان المسلمين، فلم يكن هنالك نموذج تنمية اقتصاديّة يستجيب لمطالب الشعب المصري، وأيضًا عدم خبرة الإخوان المسلمين على قيادة الدّولة، والعمليات الدستوريّة الفاشلة وأيضًا عداء البيروقراطيّة المصريّة ومؤسسات الدّولة للإخوان المسلمين[2]. ولم تتخيّل أدبيّات العقل العربي أن تصل جماعة الإخوان المسلمين إلى السّلطة، كوْنِها كانت محظورة قانونيًا، وكانت تمارس أعمالها في الخفاء، ليس بصفتها جماعة سريّة، وإنّما بصفتها جماعةً تعيش حالة قمع سياسيّة واجتماعيّة، هذه الجماعة التي انتقلت من مربّع المعارضة إلى قمّة هرم السُّلطة المصريّة، وهذه المفاجأة، لأنّ الجماعة كانت تطمح إلى بناء شرعيّة لوجودها، أي البحث عن اعتراف رسمي بها، عن طريق السماح لأفرادها بالعمل، إلّا أنّ “الإخوان” وصلوا إلى الحكم، بطريقةٍ ديمقراطيّة. وكان الرئيس مرسي، أول رئيس مدني مُنتخب في تاريخ الدولة المصريّة الحديثة. وبالتّالي، ومع صدمة الوصول إلى الحكم، اعتبرت الأدبيّات أنّ أخطاء الإخوان المسلمين كثُرت، وكان أوّل خطأ حقيقي تعديل الدستور عبر منح صلاحيات واسعة لرئيس السّلطة دونًا عن السلطات الأخرى، بالإضافة إلى تكاتف الأحزاب الليبراليّة مع المنظومة العسكريّة من أجل التخلُّص من وجود الإخوان في رأس الهرم، وتشكيل ما يُسمّى بجبهة الإنقاذ، والتي كانت مكوَّنة من مجموعة من البيروقراطيين، وأيضًا الفاعلين غير المنتخبين، أي “الدّولة العميقة”[3].
من جهةٍ أخرى، كان الإسلام السياسي تونسيًا ممثلًا في حركة النهضة التونسيّة، حاضرًا في خِضم غياب السلطة السياسيّة التي وقع إسقاطها جرّاء الثورة، والجدل الحاصل بين الخطاب السياسي للحركات الإسلاميّة الذي ينادي في باطنه تطبيق الدولة الإسلاميّة، انصهر واندمج ضمن حدود دولة القانون واحترام السيادة، بالإضافة إلى تفعيل مبادئ المساواة والحريّات العامّة، وهي مؤشّرات الدّولة المدنيّة، وأصبحت حركة النهضة واقعة في هذا الصّراع، بعد أن كانت رافضة الديمقراطيّات باعتبارها تقليدا للنظم الغربيّة، ولكنّها تحوّلت فيما بعد إلى اختيار التيار الاعتدالي الوسطي لإدارة المرحلة الانتقاليّة، الذي يوافق بين الواقع الاجتماعي والشموليّة الإسلاميّة يرافقهما الانفتاح على الحداثة العالميّة، وهو ما كان واضحًا جليًا في البرنامج الانتخابي لحزب النهضة، ما أشعل أزمة هويّة داخل الحزب الإسلامي، لأنّه تخلّى عن نشاطه الدّعوي، وركّز في العمل السياسي، ما أدى إلى عدم تكيّفه مع كونه قوّة قادرة على التغيير الاجتماعي والاقتصادي، وهذا ما كان واضحًا عندما أصرّت قيادة “النهضة” على التأقلم بعد مؤتمر عام 2016 والتركيز على العمل السياسي مع ما يقتضيه من التحفيزات للحفاظ على القاعدة الأساسيّة لأنصار الحزب.
ومن التحديات التي واجهها حزب النهضة ومنعته من استمراريّته في ممارسة الحكم، عدم معرفته كيفيّة اشتغال الدولة، لأنّ الدولة العربيّة، بطبيعة الحال، مبنيّة على شبكة راسخة من الامتيازات والمصالح، وحاجتها للخبرات والدراية التكنوقراطيّة. وانتهت قصّة حزب النهضة في تونس بعد القرارات المتتاليّة للرئيس قيس سعيّد الغريبة، فقد انقلب على المسار الديمقراطي في البلاد، بعد أن جمّد عمل البرلمان الذي يسيطر عليه حزب النهضة الإسلامي، ورفع الحصانة عن النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذيّة، عبر تعيين رئيس وزراء جديد، حتّى وصل به الأمر إلى التهديد بحل المجلس الأعلى للقضاء، والذي فيه تجاوز للدستور التونسي، باعتباره انقلابًا صريحًا، وحصر السلطات في قبضة سعيّد، لكن المفارقة بين تجربتي الانقلاب في تونس ومصر، أنّ النخب التونسية ومؤسساتها المدنية، وبخلاف الحالة المصريّة، رفضت “انقلاب” قيس سعيّد. وهنالك مخاوف حقيقيّة ما زالت ظاهرة من تعطيل المسار الديمقراطي في تونس، وهذا لا يعني تأييد حزب النهضة، وإنّما تحميلها جزءا من المسؤوليّة عما آلت إليه الأوضاع.
وبالنسبة للمغرب، فقد مُنِي حزب الإسلام السياسي، العدالة والتنميّة، بخسارةٍ في شعبيّته بعد سقوطه في الانتخابات التشريعيّة بعد مرور عشر سنوات على تصدّره المشهد السياسي في المغرب، وهذا يعود إلى أسبابٍ عدّة، أهمها افتقاد الحزب برنامجا اقتصاديا – اجتماعيا يحقِّق العدالة. وفي خضم متابعة أداء الإسلام السياسي منذ ثورات الربيع العربي وحتّى عام 2019، كان من الواضح تطبيع الحركات الإسلاميّة مع الواقع العربي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد أن كانت الحركات الإسلاميّة تعارض أنظمة الحكم وطريقة الحكم، أصبحت جزءًا منها، كما سياسة التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولربما هي كانت الفضيلة الوحيدة المتبقيّة لتيارات الإسلام السياسي، وهو موقفها الصارم من العلاقة مع إسرائيل، إلّا أنّ رئيس حكومة المغرب، ورئيس حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، سعد الدين العثماني، وقّع ثلاث اتفاقيات تطبيع مع دولة إسرائيل. وهنا يمكننا الفهم أنّ الإسلاميين في السّلطة والمعارضة، يتحرّكون ويتصرّفون كما الفواعل السياسيّة الأخرى، لتحقيق أهدافٍ مبنيةٍ وفق تحالفات لا أيديولوجيّات، ويتصرّفون كما أي حاكم عربي، آخذًا الانتهازيّة السياسيّة “تجربة وممارسة” قديمة وحديثة، كما لو أنّ الثورات لم تحدُث، وهذا لا يُعدُّ خللًا في الإسلام السياسي، وإنّما في منظومة الدّولة بشكلٍ عام، ومدى تفشّي علامات الانتكاس السياسي. وهذا ما أثبتته حركات الإسلام السياسي، أنّ الدولة العربيّة مأزومة، وتجربة الإسلاميين ومشاريعهم السياسيّة زادت الواقع تأزّمًا، لأنّها، في معظمها، شعارات ابتعدت عن الواقع كثيرًا، وتعرّضت لانتكاساتٍ بفعل عسكرة الدول العربيّة، ما أثّرت في سرديّة الشرعيّة لأحزاب الإسلام السياسي، لأنّ الأحزاب فشلت في تقديم سرديّة جديدة مغايرة لسرديّة القرن الماضي في بناء/ إصلاح دولة عربيّة، وهذا ما ظهر جليًا عندما نظرت الشعوب العربيّة إلى الأحزاب الإسلاميّة باعتبارها طرفًا سياسيًا، فاصلة بين المكون الديني للخطاب والممارسة السياسيّة. والصراع الذي يدور اليوم داخل الأنظمة العربيّة، إن بقي هنالك صراع، بين أحزاب الإسلام السياسي وما يقابلها من تيّارات علمانيّة، هو صراع على النفوذ والتأييد السياسي واستخدامه التعبئة والحشد، والإسلام أحد أدوات الصّراع لا جوهره.
في الموجة الأولى من الربيع العربي كان الإسلام السياسي في المعارضة ضدّ الحكّام والأنظمة القائمة. وفي الموجة الثانية من الربيع العربي كان الإسلام السياسي جزءًا من النّظام حكامًا أو داعمين، وأوجد ديناميكيّة مختلفة للإسلام السياسي كما “تونس، لبنان، السودان العراق”، وأصبح الإسلام السياسي داخل هذه الأنظمة يحشد ضدّ أطراف أخرى من الإسلام السياسي في السّلطة. وببساطةٍ شديدة، أظهر هذا مدى عمق الانقسام بين حركات الإسلام السياسي في العالم العربي، إذًا هنالك فواعل تسيطر على السلوك السياسي عند الإسلام السياسي أكثر من الأيديولوجيا.
خاتِمة
إذًا عندما نتحدّث عن إسلام سياسي بديلا للحكم في المنطقة العربيّة، يجب أن يكون للإسلام السياسي دور مباشر في الثورة الديمقراطيّة في الدول العربيّة، كما حصل في الانتخابات المصريّة والتونسيّة والمغربيّة أيضًا، وبالتّالي دور الإسلام السياسي أساسي في عمليّة التحول الديمقراطي، لا أن يكون بديلًا بالكامل عن أنظمة الحكم، لأنّ لدى الدّولة العربيّة سيرورة تاريخيّة ثقافيّة، لا يمكن تجاوزها ببساطة، خصوصا وأنّ معظم الأنظمة العربيّة عاشت انقلاباتٍ بينها وبين بعضها، والتي بدورها عملت على ظهور فواعل داخل أطر الدّولة، أصبحت جزءا من مكوِّنات الدّولة العربيّة، كما الحالة في المنطقة، لأنّ هنالك خصوصيّة في العالم العربي، وهذا ما ذكره عزمي بشارة في كتابه “المسألة العربيّة”، أنّ المنطقة العربيّة لا تعيش حالةً من ثابت، وما زالت تناقش مفهوم الدّولة، والأمّة، والهويّة، أي أنّ النّظام ليس ثابتًا ومتّفقا عليه، بأمن قومي ونظام اقتصادي ثابت، والانتخابات تجري تحت ظلّ هذه الثوابت. وبالتّالي، لو أرادت الأنظمة العربيّة أن تبني ثوابت، يصبح أي حزب إسلام سياسي جزءا من هذه الثوابت المتّفق عليها، وتستطيع أن تصِل إلى السّلطة بانتخاباتٍ من دون أن تكون بديلًا صارخًا، وإنّما مرورًا ديمقراطيًا.
الأهم من هذا، لا تستطيع الحركات الإسلاميّة أن تدير ظهرها وتتصرّف كحزب يريد الوصول إلى السّلطة فقط في خِضم غياب الثوابت. وعليه، تعيش أزمة هويّة كما حصل في الحالتين التونسيّة والمغربيّة. وعلى هذا، الهدف من وجود الإسلام السياسي اليوم محاولة الإجابة عمَّ هي الأمّة، وما هي الهويّة، والدّولة، وحتّى مفهوم النّظام، ولن يمكنك أن تتمكّن من استيعاب “المواطنة” من دون فهم “الأمّة”، وهذا لن يصلح إلّا في حالة واحدة، أن تستفيد أحزاب الإسلام السياسي من تجربة التيّار القومي العربي، والقوى الوطنيّة داخل البلاد العربيّة، لترى ما إذا كان الإسلام السياسيّ يمكنه أن يكون “بديلًا” لأنظمة الحكم، من دون أن يعيد تكرار تجربة الفشل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس