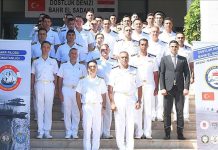افريقيا برس – مصر. برزت ثلاث ظواهر متباينة القوة والشعبية طرحت نفسها كبدائل للسيسي استغل السيسي السياسيين المدنيين لمنح “غطاء شعبي مصطنع” لخطواته غضبت دائرة السيسي من دعم عدد من قيادات المخابرات لعنان
خلال سنوات عشر مرت على ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تعرض الشعب المصري لممارسات سياسية وإعلامية ودعائية مكثفة من قبل الجيش والأجهزة “السيادية”، لمنع تكرار الطابع الشعبي التلقائي غير المسبوق في تاريخ مصر، إلا في ثورة 1919، وحصر إمكانية التغيير بتداول السلطة، سلمياً أو بالقوة، في خيارات عسكرية بعيدة في الواقع عن الإرادة الشعبية، تحاول طوال الوقت تصوير ذاتها كقيادة محتملة لحراك أهلي مدني لا تعلم عنه شيئاً، ولم تنخرط مع فئاته الاجتماعية ولم تعش معاناته وطموحاته. بل كانت تلك الخيارات العسكرية في معظم الحالات جزءاً من السلطة الواقعية القائمة أو النظام الحاكم، وبالتالي فهي لا تصلح -في التحليل الأخير للمشهد السياسي بتغيراته المختلفة منذ الإطاحة بنظام حسني مبارك وخلعه- كبديل لما هبت جموع المواطنين لإسقاطه.
واتخذت هذه المحاولات صوراً عدة منذ اندلاع الثورة، وليس فقط بعد الانقلاب عليها في الثالث من يوليو/تموز 2013. وكان بعضها بإرادة وتدبير كاملين، وبعضها الآخر عبر استغلال الموقف وسلامة النوايا. وقد بدأت من خلال الترويج لمجموعات وأشخاص عسكريين بدعوى اتحادهم مع الشعب في مطالبه الثورية، في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بدأت المحاولات من خلال الترويج لمجموعات وأشخاص عسكريين بدعوى اتحادهم مع الشعب في مطالبه الثورية
وجاء على رأس هذه المحاولات حركة “ضباط 8 إبريل”، الذين ظهروا للمرة الأولى في الثامن من إبريل/نيسان 2011 مطالبين بنقل السلطة لمجلس رئاسي مدني، وتعرضوا أمام الرأي العام لتعسف واعتقال وأحكام عسكرية، تم تخفيفها وجعلها “مع إيقاف التنفيذ” لاحقاً، وسط تعاطف شعبي وتظاهرات وترويج إعلامي كبير، حتى من الوسائل المؤيدة للثورة. ثم تم العفو عنهم جميعاً قبل تولي محمد مرسي الرئاسة في يونيو/حزيران 2012. كما أن بيانهم الختامي، وظهورهم الأخير في 21 يوليو 2013، ألقى بظلال من الشكوك في منهجهم ومسيرتهم منذ بداية الثورة، عندما أكدوا للرأي العام رفضهم لمحاولات تصويرهم كجبهة معارضة، أو انشقاق داخل القوات المسلحة، مستخدمين نفس عبارات المجلس العسكري الشائعة آنذاك: “نحن لم ولن نكن رجال سياسة، وليس لنا أهداف شخصية، وإنما نحن رجال القوات المسلحة وهدفنا وواجبنا حماية الوطن ومقدرات شعبنا العظيم”.
واكتملت سلسلة الارتياب في مصداقية حراك “ضباط 8 إبريل” بعد عودة عدد منهم إلى الخدمة بين 2013 و2014 وحصولهم على الترقيات الطبيعية المقررة لهم. لكن هذه الشكوك لا تنفي أن المجموعة كان بها عدد من الضباط، أصحاب النوايا الحسنة المطابقة لأهداف ثورة يناير، الذين دفعوا الثمن بعدم عودتهم لأعمالهم. لكن ظهور المجموعة وإدارتها بهذا الشكل لا يمكن تصنيفه اليوم إلا كمحاولة من داخل الجيش نفسه لتشتيت الثوار، وبث شعور كاذب بإمكانية الرهان على كيانات عسكرية لتحريك الوضع السياسي، ورفع شعبية الجيش، في وقت كانت فيه في أدنى مستوياتها، نتيجة التفاف المجلس العسكري باستمرار على مطالب الثوار.
وبالتوازي مع افتعال ذلك الحراك الثوري، من الميدان، دفع الجيش والأجهزة السيادية الأخرى بعدد كبير من الشخصيات العسكرية والاستخباراتية في الفترة السابقة على انتخابات الرئاسة في 2012، لتجربة حظ كل منها في نيل شعبية تمكنها مجابهة القوى الثورية والمدنية. فعدا مدير المخابرات العامة عمر سليمان، الذي كان قد أعلن ترشحه للرئاسة، متحدياً خصمه اللدود رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، ودفع ثمن ذلك باستبعاده سريعاً من السباق، كان طنطاوي وأعوانه -ومنهم مدير المخابرات الحربية وقتها عبدالفتاح السيسي- هم من أعطوا الضوء الأخضر لمشاركة باقي الشخصيات العسكرية في الانتخابات، على أمل وصول أحدهم إلى السلطة ليسهل الانقضاض عليه. وكان التصور القائم آنذاك، أن وصول مرشح غير عسكري، ينتمي لمعسكر الثورة لقصر الرئاسة، سواء كان إسلامياً أم علمانياً، سوف يؤدي لتغيير شامل في إدارة القوات المسلحة، ويبعدها على مراحل عن المشاركة في صنع القرار السياسي. وقد انعكس هذا الأمر في التحرك الأخير للمجلس العسكري قبل إعلان فوز مرسي بالرئاسة، وهو إصدار الإعلان الدستوري “المكبل” عقب حل مجلس الشعب المنتخب، والذي أقحم المجلس العسكري بديلاً للبرلمان في سلطة التشريع، وقائماً على الرقابة وتنظيم وضع الدستور الجديد.
وشهدت الفترة التحضيرية لانتخابات 2012 استبعاد عدد من المرشحين، ليبقى من المحسوبين على الجيش والأجهزة السيادية ثلاثة، هم رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق أحمد شفيق الذي كانت تجمعه بطنطاوي علاقة جيدة منذ عهد مبارك، والوكيل السابق لجهاز المخابرات حسام خيرالله، ضابط الحراسات السابق محمود حسام. وكان طبيعياً أن تقف الأدوات الإعلامية التابعة للجيش جنباً إلى جنب مع فلول نظام مبارك، لدعم شفيق الذي وصل إلى جولة الإعادة، وخسر بصعوبة أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين، الذي أيده قسم كبير من القوى الثورية لمنع إعادة إنتاج نظام ثار عليه الشعب.
وبعد استغلال مرسي انهيار شعبية المجلس العسكري لاتخاذ قراراته بتغيير وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان في أغسطس/آب من نفس العام، وتصعيد السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً، بدأت تروس الثورة العسكرية المضادة في العمل مرة أخرى، وصولاً للانقلاب بعد عام واحد من رئاسة مرسي. لكن ما يلاحظ هنا أن الأدوات الإعلامية والدعائية للجيش والأجهزة، أديرت معظمها بواسطة شخصيات ناصرية ويسارية -كان بعضها يتصور عن جهل أو بعد عن الواقع السياسي- أن السيسي سيقود تصحيحاً لمسار الثورة، يتمثل من منظورهم الضيق في إقصاء “الإخوان” فقط. ليبدأ الترويج مرة أخرى -منذ مطلع 2013- إلى حل “ثورة العسكر” كرهان وحيد معلق على المؤسسة العسكرية كوحدة واحدة، أو على شخصية متميزة بها، هرباً من المواجهة الديمقراطية مع “الإخوان” والسلفيين في صناديق الاقتراع لمجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها في ذلك العام. وكرست حركة “تمرد”، التي مولتها الإمارات واكتسبت دعماً إعلامياً غير محدود وحرية حركة من المخابرات العامة والأمن الوطني، فكرة “ثورة العسكر” في نفوس المصريين الغاضبين من أداء مرسي وحكومته، بهدف حشد الملايين في الميادين في 30 يونيو 2013. ورغم انخفاض الأعداد بشدة في اليوم التالي، وظهور الأمر وكأن الوضع في طريقه للاستقرار، أصدر السيسي بيانه الأول الشهير بمهلة 48 ساعة، ليعيد المتظاهرين إلى الميادين، ويفرض نفسه بقوة السلاح لاعباً أوحد على الساحة، ويدبر مشهد الثالث من يوليو، الذي جمع ممثلي مختلف مؤسسات الدولة المناهضة لثورة يناير، وراء “العسكري” رأس حربة الثورة المضادة.
اكتملت سلسلة الارتياب في مصداقية حراك “ضباط 8 إبريل” بعد عودة عدد منهم إلى الخدمة كان من شأن هذا المشهد المرسوم بعناية ترسيخ أن الدولة المصرية لن تسمح لمدني بالوصول للحكم، وأن الثورة الشعبية محض خيال شباب ومراهقي يناير، وأن الثورة الحقيقية التي يترتب عليها تغير في الحياة العامة ومرافق الدولة يجب أن تكون عسكرية، أو بقيادة عسكريين. وهو ما انعكس على مراحل في أداء نظام السيسي الذي ولد رسمياً في ذلك اليوم، باستغلال السياسيين المدنيين لمنح “غطاء شعبي مصطنع” لكل خطوة قام بها في الفترة الانتقالية، من القضاء على الوجود “الإخواني” في الشارع، بمذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ثم إلغاء دستور 2012 ووضع دستور جديد للبلاد بما يفتعل إقامة دولة جديدة، ثم دخول حمدين صباحي ممثلاً للتيار الناصري التقليدي منافساً للسيسي في انتخابات محسومة سلفاً، كديكور ممهد لانتقال السلطة رسمياً لقائد العسكر.
وساهمت التطورات التالية في حكم السيسي، من ملاحقة المعارضين وقمع الأصوات المخالفة، والتخلص على مراحل من الشركاء السابقين في لحظة الانقلاب أو تقزيم أدوارهم، في انهيار المعارضة المدنية على المستوى السياسي، خاصة بعد استئثار النظام بالأغلبية الكاسحة من مقاعد مجلس النواب، والتلاعب بنتائج انتخابات الاتحادات الطلابية لإقصاء الإسلاميين واليساريين واستمرار تجميد انتخابات المحليات.
وفي ظل هذا الخواء المدني، برزت ثلاث ظواهر متباينة القوة والشعبية، طرحت نفسها كبدائل “عسكرية” للسيسي. وكان الدعم الأساسي لكل منها ينطلق من دوائر مختلفة ساخطة على النظام من داخله، سواء من الجيش أو المخابرات أو الأمن الوطني، تتناقض بالتأكيد مآربها وطرقها لمقاربة الأوضاع السياسية، ولكنها تجتمع على ضرورة تسليم مقاليد الحكم بمصر لشخصية عسكرية، واستغلال الشعب فقط كأداة لتصوير شعبية متوهمة أمام الرأي العام العالمي، بما يعكس هشاشة وسطحية مبادئها وافتقار حراكها للشعبية الحقيقية، وانفصالها عن أحلام وآمال المواطنين التي عبروا عنها في يناير 2011.
كانت الظاهرة الأولى محدودة التأثير، لكن السيسي استغلها لقمع الأصوات المعارضة من المؤسسة العسكرية، وللتأكيد على تبعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة له وحده. وبدأت بإعلان ضابط مغمور، هو العقيد أحمد قنصوة، نيته الترشح في انتخابات الرئاسة في 2014 ضد السيسي، وأنه تقدم من قبل باستقالات متكررة من الجيش لم تقبل، حتى لجأ لمقاضاة وزارة الدفاع أمام المحكمة الدستورية العليا. وعلى الفور تحركت آلة القمع باعتقاله، ثم قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية بسجنه لمدة ست سنوات مع الشغل والنفاذ، بدعوى “نشر مقطع فيديو يتناول فيه بعض الآراء السياسية بالمخالفة للتعليمات والأوامر العسكرية”.
أما الظاهرة الثانية، فكان بطلها أحمد شفيق، الذي كان يعتقد بعد الانقلاب أنه الأحق بالرئاسة من السيسي وأي عسكري آخر لم يمارس السياسة، ويردد في اجتماعاته الخاصة ومناسبات عامة بمصر والإمارات أنه كان المحرك الأول “للثورة الشعبية على الإخوان”. وكشف أنه كان متحالفاً مع قضاة ورجال أعمال وإعلاميين لتقويض حكم مرسي، في محاولات متكررة للحصول على دعم الإمارات للعودة كرئيس للبلاد، وللتشكيك في أهمية وحسم الدور الذي أداه السيسي لإنهاء عهد مرسي. وهو ما تصادم بالطبع مع رغبات السيسي في الوصول للسلطة منفرداً، من دون أن تكون عليه فواتير يجب دفعها لأحد، أو قضايا لها ذيول تُشكك في شرعية عهده الرئاسي. أديرت معظم الأدوات الإعلامية والدعائية للجيش والأجهزة بواسطة شخصيات ناصرية ويسارية
وبعد فشل شفيق في تشكيل خطر حقيقي على السيسي، وفترة صمت بين الطرفين، مثلت قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مناسبة مؤاتية لشفيق ليعود للواجهة، مدعوماً من عسكريين وقيادات استخباراتية ارتأت أن انخفاض شعبية السيسي في تلك الفترة يمكن أن تنهي عهده مبكراً، وفكرت في تقديم شفيق كبديل عسكري مناسب له، وفي نفس الوقت يحظى بدعم فلول مبارك الذين كانوا ما يزالون يبحثون عن زعامة تنسق جهودهم وتجمعهم. فجرت اتصالات خلال إقامته بالإمارات انتهت بدخوله في مغامرة -يبدو أنها كانت محسوبة من قبله ليضمن العودة لمصر ويقضي بها سنواته الأخيرة- حيث أعلن ترشحه للرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، من خلال مقطع فيديو سلمه لوكالات عالمية، ثم ما لبث أن اعتذر عن الترشح، وبعدها بأيام تم ترحيله باتفاق إماراتي مصري إلى القاهرة، ليبقى لفترة تحت الإقامة الجبرية بأحد الفنادق، ثم يُسمح له بالعودة لمنزله ويدخل نفق الصمت النهائي. وكان لظهور شفيق توابع عديدة أبرزها الإطاحة بالعديد من القيادات في المخابرات. لكن الرهان الخاسر عليه، والإيهام بأنه بديل محتمل، ساهم بشكل غير مباشر في توطيد حكم السيسي وتخويف المعارضين، لا سيما بعد فتح قضايا مالية مختلفة، كانت مغلقة لعدة سنوات في القضاء العسكري والعادي، أعطت للمراقبين رسالة تأكيد على سيطرة السيسي على أدوات الحكم والتنكيل.
ثم كانت الظاهرة الثالثة، التي ساهم في صنعها بعض الشخصيات السياسية والحزبية المدنية، إلى جانب قيادات ودوائر استخباراتية وعسكرية، بترشيح الفريق سامي عنان للرئاسة عام 2018 وتصوير ذلك كأنه رهان ثوري على السيسي. وعلى العكس مما حدث مع شفيق، فقد غضبت دائرة السيسي بشدة من الخرق الداخلي في نسيج النظام، بدعم عدد من قيادات المخابرات الذين كانوا تابعين لعمر سليمان، لعنان، وفشل مدير المخابرات السابق خالد فوزي في السيطرة عليهم. وقد صاحب ذلك إظهار تناقض بين الخطاب الرسمي وتناول الإعلام الموالي للسلطة له في بعض المناسبات، كتضخيم معلومات تعثر مفاوضات سد النهضة في غير الأوقات التي يرغب فيها السيسي بذلك، والمعارضة الحادة في بعض الأحيان لقرار نقل السفارة الأميركية ب”إسرائيل” إلى القدس المحتلة والاحتفاء بالتظاهرات الرافضة، والحديث عن ضرورة وجود منافس للسيسي في الانتخابات، وإفساح المجال لبعض المعارضين للحديث في الفضائيات المملوكة أو القريبة لأجهزة النظام.
واشتبك الترويج لعنان كقيادة عسكرية بديلة، قبيل انتخابات 2018، بعبث استخباراتي وأمني واسع، أعاق جهود السيسي لتوحيد الخيوط المتحكمة في كل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في يده، فكان الحل الشامل لذلك هو توجيه عدة ضربات موجعة لمعارضي سياساته. فباستخدام المجلس العسكري قضى على عنان، ببيان شهير حوله من قائد عسكري سابق إلى متهم مخالف للقواعد العسكرية، بعد اعتباره ضابطاً تحت الاستدعاء وقد قرر المشاركة في العمل العام. ثم وجه السيسي، بتعليمات شبه علنية (عندما شكك في مؤتمر الشباب في ذمة عنان) بتحريك قضايا مالية، جردت عنان وأسرته من معظم ثرواتهم العقارية والمالية، ثم اعتقله وأودعه محبساً خاصاً.
وبالتزامن أحيل إلى المعاش المبكر عشرات من ضباط سلاح الدفاع الجوي، الذين اشتبه السيسي بتبعيتهم لعنان وتعاطفهم معه، وغير إدارة المخابرات، معيناً ذراعه الأيمن عباس كامل على رأسها، وأحال أكثر من 200 ضابط وموظف كبير للمعاش، أو للعمل الإداري بجهات أخرى. كما اعتقلت أجهزته كل السياسيين المدنيين الذين ساعدوا عنان في مراحل مختلفة، مثل المتحدث باسمه الدكتور حازم حسني ومساعده في الحملة المستشار هشام جنينة، وصولاً إلى من تواصل عنان معهم لدراسة الأوضاع، مثل رئيس حزب “مصر القوية” عبدالمنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.
وانقضى وقت الظاهرة الثالثة بدلائل إضافية على عدم صلاحية العسكر لقيادة حراك ثوري، أو حتى إصلاحي من داخل عباءة النظام، ليس فقط لانفصالهم عن واقع الشارع وأهدافه، ولكن لسهولة النيل منهم، واستخدامهم ذريعة لضرب احتمالات التغيير وإحكام غلق المجال العام، بواسطة قوانين وقيود خاصة داخل المؤسسة العسكرية، تجعل من المستحيل الإفلات من براثنها لممارسة العمل العام بحرية ونزاهة. وقد زادت شراستها في عهد السيسي على مراحل مختلفة، كان أحدثها في يوليو الماضي إصدار نص قانوني صريح يمنع الضباط السابقين -شأن الحاليين- من الترشح لأي انتخابات دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تم إضافة نص آخر يعبر تماماً عن رؤية السيسي للمؤسسة العسكرية كسلطة قائمة على منع أي تغيير مدني في البلاد، أو حصر للجيش في دوره العسكري، بالتأكيد على سلطتها في “صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب…”. وهذه الصياغة تعيد إلى الأذهان ما حاول المجلس العسكري فرضه على الرئيس المدني الوحيد في تاريخ مصر قبل توليه السلطة عام 2012 بواسطة إعلان دستوري باطل. سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة