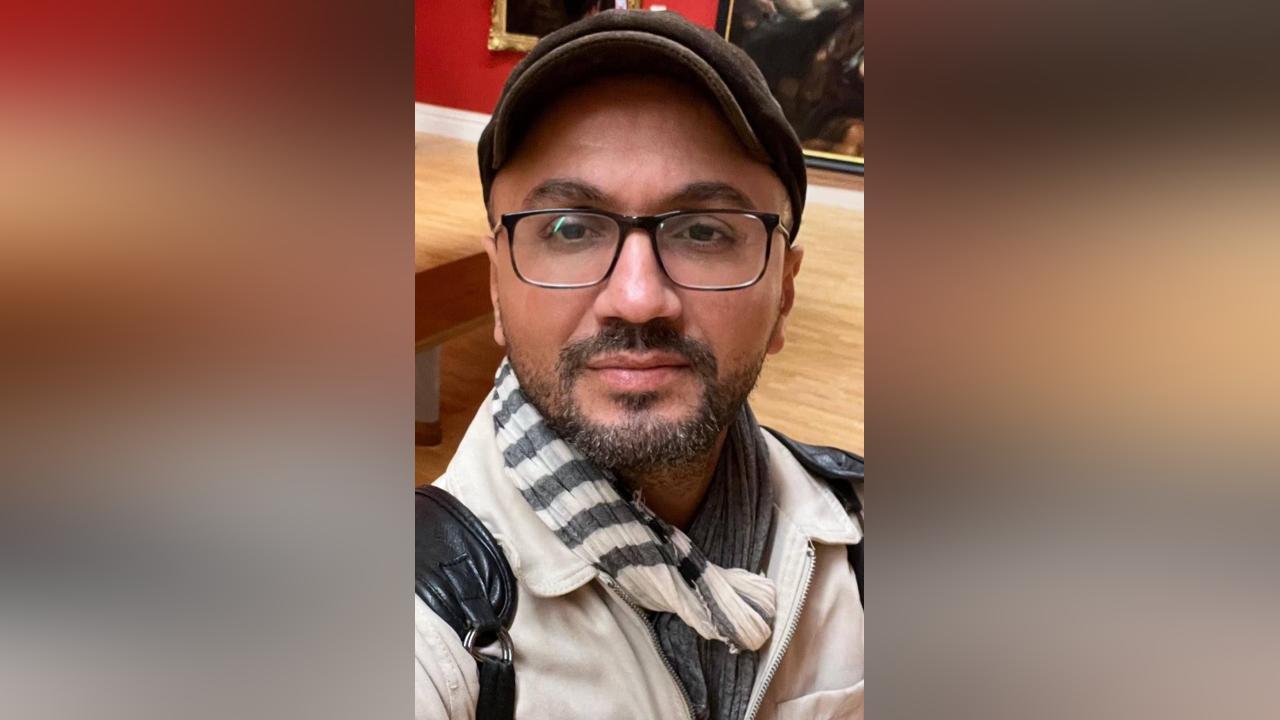عبد الرحمن البكوش
أفريقيا برس – ليبيا. في حوار أجرته أفريقيا برس، أوضح الحقوقي طارق لملوم أن الواقع الإنساني والقانوني في السجون الليبية ما زال مقلقًا ومخيفًا للغاية، مشددًا على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز تستدعي تحركًا عاجلًا من السلطات القضائية والحقوقية. وأكد لملوم أن غياب الرقابة القضائية الفاعلة واستمرار هيمنة الجماعات المسلحة على عدد من السجون يقوّضان مبدأ سيادة القانون ويجعلان مساءلة المسؤولين أمرًا محدودًا.
كما نوه إلى أن الانقسام السياسي والمؤسسي أدى إلى تباين أوضاع السجون بين الشرق والغرب والجنوب، في حين تبقى القواسم المشتركة بينها جميعًا هي غياب الشفافية وضعف الإشراف القضائي. وأشار لملوم إلى أن تحقيق العدالة والمساءلة يمثلان الأساس لأي استقرار حقيقي في ليبيا، محذرًا من أن تجاهل الجرائم أو التسامح مع مرتكبي الانتهاكات سيؤدي إلى إعادة إنتاج العنف والانقسامات.
طارق لملوم هو حقوقي ورئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، عمل على العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.
كيف تصف الواقع الإنساني والقانوني في السجون الليبية؟
الواقع الإنساني والقانوني في السجون الليبية ما زال مقلقًا ومخيفًا للغاية، حيث تشهد العديد من أماكن الاحتجاز انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة دون محاكمة، وغياب الرقابة القضائية الفاعلة، خصوصًا في السجون التي تسيطر عليها جماعات مسلحة تتبع اسمياً وزارة الدفاع وتزعم أنها تتواصل مع مكتب النائب العام. على سبيل المثال، السجون الواقعة في الكتيبة 55 مشاة بمنطقة ورشفانة، وكذلك السجون الموجودة داخل مقرات اللواء طارق بن زياد في شرق ليبيا، تُعد من أسوأ أماكن الاحتجاز.
كما تشهد غالبية السجون اكتظاظًا وسوء معاملة، وتخضع فعليًا لإدارة جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة، مما يقوض مبدأ سيادة القانون ويحد من مساءلة المسؤولين. ومن الناحية القانونية، لا يتم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ما يجعل بيئة الاحتجاز أقرب إلى مراكز غير قانونية منها إلى مؤسسات عقابية خاضعة للرقابة.
هل تختلف ظروف الاحتجاز والمعاملة بين مناطق الشرق والغرب والجنوب؟
نعم، هناك تباين واضح في ظروف الاحتجاز والمعاملة بين المناطق نتيجة الانقسام السياسي والمؤسسي. في المنطقة الغربية، تتعدد الجهات التي تدير السجون، بما في ذلك كيانات أمنية تابعة لوزارات مختلفة وتشكيلات مسلحة، مما يؤدي إلى تضارب الصلاحيات وغياب الرقابة المنتظمة. أما في المنطقة الشرقية، فتبرز الهيمنة العسكرية على إدارة أماكن الاحتجاز مع تشديد أمني أكبر وقيود على الزيارات والمتابعة الحقوقية، رغم وجود مزاعم بوقوع انتهاكات وظروف احتجاز غير إنسانية. وفي الجنوب، تعاني السجون من ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية وقلة الرقابة، مع تسجيل حالات احتجاز في ظروف قاسية وغير إنسانية حتى في السجون التابعة لوزارة العدل، مثل مؤسسة الإصلاح والتأهيل أوباري، التي وصفها فريق حقوقي بأنها معتقل لا يصلح لاحتجاز البشر. ورغم هذا التباين، يبقى القاسم المشترك بين المناطق الثلاث هو ضعف الإشراف القضائي وغياب الشفافية في أوضاع المحتجزين.
ما مدى تعاون مكتب النائب العام مع المنظمات الحقوقية في متابعة قضايا المعتقلين؟
التعاون بين مكتب النائب العام والمنظمات الحقوقية لا يزال محدودًا وغير مؤسسي. ورغم وجود حالات تواصل فردية واستجابات جزئية لبعض القضايا، إلا أن غياب آلية رسمية للتنسيق أو قنوات اتصال دائمة يعوق العمل الحقوقي. كما أن حساسية الملفات المرتبطة بانتهاكات صادرة عن جهات مسلحة أو أمنية نافذة تحدّ من إمكانية التعاون الفعّال، وهو ما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الشفافية والتفاعل الإيجابي مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
هل تواجه المنظمات المحلية والدولية صعوبات في الوصول إلى أماكن الاحتجاز وجمع المعلومات؟
نعم، تواجه المنظمات صعوبات كبيرة في الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز. فالحصول على تصاريح الزيارة يتطلب موافقات أمنية متعددة، وغالبًا ما تُرفض الطلبات أو تُؤجل لأسباب أمنية. كما أن منع التأشيرات للمنظمات الدولية أو تعطيلها أصبح أمرًا ممنهجًا وغير مبرر. غياب قاعدة بيانات واضحة بالمحتجزين، والخوف من الانتقام، وغياب ضمانات الحماية للشهود والضحايا، تجعل عملية جمع المعلومات شديدة التعقيد. وتزداد هذه الصعوبات في المرافق غير الرسمية التي تديرها مجموعات مسلحة خارج الإطار القانوني للدولة.
إلى أي مدى تؤثر الاعتبارات السياسية على مسار التحقيقات في قضايا الانتهاكات؟
الاعتبارات السياسية تؤثر بشكل مباشر في سير التحقيقات، خاصة في القضايا التي تطال شخصيات أو جهات نافذة. فكثير من الملفات يتم تجميدها أو تهميشها خوفًا من ردود فعل سياسية أو أمنية، وهذا التدخل يضعف استقلال القضاء ويقوض الثقة في منظومة العدالة، مما يجعل العدالة الانتقائية واقعًا ملموسًا. الحل يتطلب ضمان استقلال النيابة العامة وتوفير حماية قانونية للمدعين العامين الذين يتعاملون مع القضايا الحساسة.
هل توجد قاعدة بيانات موحدة أو جهود رسمية لتوثيق حالات الاختفاء القسري في ليبيا؟
لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات وطنية موحدة وشفافة لحالات الاختفاء القسري. الجهود الحالية مشتتة بين هيئات رسمية ومنظمات أهلية مقيدة، وغالبًا ما تفتقر للتنسيق والمعايير الموحدة للتوثيق. كما لا تتوافر آلية للتحقق المتبادل من المعلومات أو لتحديثها بشكل دوري. وجود قاعدة وطنية مستقلة لتوثيق المفقودين والمختفين قسرًا يمثل خطوة أساسية لكشف الحقيقة وضمان حق الأسر في المعرفة والمساءلة. فعلى سبيل المثال، في شرق ليبيا لا يمكن حصر المحتجزين داخل السجون التابعة للجهات المختلفة، وكذلك الحال في الغرب الليبي.
ما الخطوات العملية المطلوبة لكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم؟
يتطلب الأمر إنشاء آلية وطنية مستقلة تُعنى بالمفقودين والاختفاء القسري، مزودة بصلاحيات تحقيق كاملة وميزانية مستقلة. ينبغي توثيق الحالات وفق المعايير الدولية مثل بروتوكول مينيسوتا، وتفعيل فرق الطب الشرعي وبنوك الحمض النووي (DNA)، مع حماية أسر الضحايا والشهود. كما يجب ضمان إحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء الوطني أو الدولي، وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب.
كيف يمكن تفعيل قانون العدالة الانتقالية في ظل استمرار الانقسام السياسي؟
رغم الانقسام القائم، يمكن تفعيل العدالة الانتقالية عبر تشكيل هيئة مستقلة جامعة تمثل جميع المناطق وتعمل تحت مظلة توافق وطني. ينبغي البدء بمسار تدريجي يركز على توثيق الانتهاكات، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، مع إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية تدريجيًا. إعادة تفعيل القانون تتطلب توافقًا سياسيًا حول مبدأ عدم الإفلات من العقاب كشرط لأي مصالحة وطنية مستقبلية.
ما دور الضحايا وذويهم في مسار المصالحة الوطنية؟
الضحايا وذووهم يجب أن يكونوا في قلب عملية المصالحة لا على هامشها. مشاركتهم ضرورية في تصميم وتنفيذ برامج جبر الضرر وكشف الحقيقة، وضمان سماع أصواتهم باعتبارهم أصحاب الحق المباشر. كما ينبغي تمكينهم من الوصول إلى العدالة والمعلومات، وضمان تمثيلهم في اللجان الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمصالحة.
هل ترى أن تحقيق العدالة والمساءلة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا؟
نعم، تحقيق العدالة والمساءلة هو الأساس لأي استقرار مستدام. فالتجارب المقارنة تُظهر أن تجاهل الجرائم أو التسامح مع مرتكبي الانتهاكات يؤدي إلى إعادة إنتاج العنف. الاستقرار الحقيقي يقوم على إنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات. فالعدالة ليست نقيض الاستقرار، بل هي شرطه ومصدر مشروعيته.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس