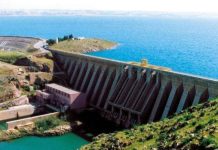محمد الحداد
أفريقيا برس – المغرب. قدمت دراسة زلزالية جديدة -نشرت يوم 30 أغسطس/آب بمجلة “ساينتفك ريبورتس”- إطارا مبتكرا لتقييم مخاطر الزلازل على الأبنية السكنية في منطقة السيب بمدينة مسقط (سلطنة عمان) وذلك باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وعملية التحليل الهرمي.
واستخدم المؤلفون المسح البصري السريع للأحياء، في الفترة بين فبراير/شباط ومايو/أيار 2025، لتوثيق خصائص المباني من حيث الارتفاع والعمر ونوعية البناء، إلى جانب دمج البيانات الجيوتقنية والاجتماعية.
ويقول الباحث الرئيسي بالدراسة عبد الله الأنصاري (أستاذ باحث في مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في مسقط بعُمان) إن ما يميز هذه الدراسة أن الفريق جمع بين 3 مستويات من البيانات نادرا ما تدمج في خريطة واحدة: ظروف التربة، خصائص المباني، العوامل الاجتماعية مثل الكثافة السكانية والقرب من المنشآت الحيوية والخطرة.
ويضيف في تصريحات للجزيرة نت أنه “عبر هذه الطبقات استطعنا إنتاج مؤشر مخاطر شبكي يوضح بوضوح أي الأحياء أكثر هشاشة ولماذا، وهو ما يفتح الطريق لسياسات تخطيط عمراني أكثر ذكاء ومرونة”.
ما الأكثر عرضة؟
أظهرت الخريطة النهائية أن بعض مناطق السيب -مثل الحيل الشمالية والخوض القديمة- تقع ضمن فئة المخاطر العالية جدا، نتيجة لعمر المباني وجودة البناء المحدودة والتربة الضعيفة. كما برزت المعولة الشمالية كمزيج من المخاطر العالية والعالية جدا.
وعلى النقيض، جاءت منطقة “مسقط هيلز” في خانة المخاطر المنخفضة بفضل بنية تحتية حديثة وظروف أرضية مستقرة.
أما المنطقة الصناعية في رسيل، فقد وصفت بأنها نقطة حرجة، إذ تجتمع فيها المصانع ومحطات الوقود مع كثافة سكانية معتبرة، مما يرفع مستوى الخطر حتى مع هزات متوسطة القوة.
وتشير تقديرات الباحثين إلى أن 40% من المباني في رسيل قد تتعرض لأضرار في حال وقوع زلزال، مقابل 20% فقط في مسقط هيلز.
وتؤكد الدراسة أن الخرائط الناتجة -التي يمكن قراءتها مثل “لوحة فرز” للأولويات، فالأحياء المصنفة ضمن مناطق الخطر العالي جدا- يجب أن تكون في مقدمة جهود التدعيم والترميم، بينما يمكن للأحياء ذات المخاطر المتوسطة أن تدخل في برامج التفتيش الدوري وتطبيق جزئي لكود البناء.
كما أن معرفة سبب ارتفاع الخطر في حي معين، سواء بسبب التربة أو عمر المباني أو ضعف الوصول للمستشفيات، يسمح بصياغة تعديلات محددة في الكود، مثل تفاصيل إنشائية مخصصة للتربة الضعيفة، أو فرض تحديث إلزامي للمباني القديمة عند تغيير الاستخدام.
توصيات للمستقبل
يقدر الباحثون أن تطبيق هذا النهج في مدينة خليجية متوسطة الحجم قد يتطلب ميزانية تتراوح بين 180 و520 ألف دولار، حسب عدد المباني وتوافر البيانات.
وتشمل الحزمة الأساسية بيانات عن المباني (عمر المبنى، مواد البناء، عدد الطوابق) واستخدامات الأراضي، والسكان، والمرافق الحيوية والخطرة، وشبكات الطرق، وخصائص التربة. وإذا كانت البيانات الجيوتقنية متوافرة سلفا، فإن الكلفة تنخفض بشكل ملحوظ.
ويقول “الأنصاري” إن الدراسة تقترح مجموعة من التوصيات العملية للحد من المخاطر الزلزالية، وركزت على 5 مسارات رئيسية يمكن أن تشكّل خريطة طريق لصناع القرار والمخططين العمرانيين. وأول هذه المسارات تحديث كود البناء بحيث يتلاءم مع ظروف التربة في كل حي، بما يضمن أن تراعي التصاميم الهندسية الخصوصيات الجيوتقنية المحلية. أما المسار الثاني فيتمثل في إطلاق حملات تدعيم للأبنية، وتبدأ بالمرافق الحيوية مثل المدارس والعيادات والمباني السكنية متوسطة الارتفاع الواقعة في الأحياء الأعلى خطورة.
كما شدد الفريق على أهمية فرض حواجز فاصلة بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية أو محطات الوقود لتقليل حجم المخاطر في حال وقوع هزة أرضية. وأوصى كذلك بضرورة تحسين طرق الوصول إلى المرافق الطبية ووحدات الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة والإنقاذ.
وتدعو الدراسة إلى بناء نظام حوكمة بيانات يتيح تحديثا دوريا للمسوح البصرية والبيانات الجيوتقنية، بما يضمن استمرار دقة الخرائط والمؤشرات المعتمدة في إدارة المخاطر.
ويختم الأنصاري بالقول بأنه لا يمكن منع الزلازل “لكن يمكننا بالتخطيط السليم أن نحولها من كوارث مدمرة إلى اختبارات لقدرة مدننا على الصمود”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب عبر موقع أفريقيا برس