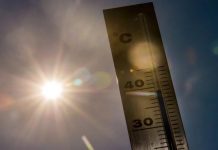أفريقيا برس – المغرب. عند غروب شمس كلّ يوم، تتوجّه فتيات الليل في “بوبو ـ ديولاسو” (غرب بوركينا فاسو) إلى منزل السيدة الثمانينية كودا، ليُودِعنَ عندها أطفالهنّ ريثما يعدن لاسترجاعهم في الساعات الأولى من الغد. لم يُصدّق موموني سانو (35 عاماً) عينيه حين اكتشف، صدفةً، هذا المنظر، هو الذي اعتاد السهر في أجواء ليل شارع “بلاك”، العاجّ بعاملات الجنس والنشّالين وتجار المخدرات، حيث يتمتّع بشعبية، والجميع ينادونه “لو شا” (القطّ).
أصرّ سانو -مُتسلّحاً بدراسته السينما وخبرته كمخرج مبتدئ، ومؤطّر ومونتير في أفلام عدّة- على خوض مسارٍ شاقٍّ وطويل، لتوفير دعم وتمويل لمشروع فيلم وثائقي عن هذا الواقع، اختار له عنوان “حضانة ليلية”. المحصّلة: فيلمٌ مرهفٌ وكثيف (67 دقيقة)، يركّز على لحظات عيشٍ دالّة لشخصياتٍ من 3 أجيال متنوّعة الأعمار والإيقاعات، تحاول التكيّف مع سياق اقتصادي صعب وهشّ: المرأة العجوز، وفراغها القاتل في النهار، ثمّ شقاؤها في رعاية الأطفال ليلاً؛ أوديل وأدام وفاطيم، المتأرجحات بين قساوة شرطهنّ ولحظات رقصٍ وابتهاج يسرقنها في العلب الليلية؛ وأطفال أبرياء يلهون في غفلةٍ عمّا يُحيط بهم، تُصوّرهم الكاميرا بصوابٍ على ارتفاع قاماتهم الصغيرة.
يقبض المخرج الشاب على كلّ ذلك من دون أنْ تسقط نظرته، في أي من لحظات الفيلم، في التلصّص، أو الإثارة السهلة، أو البؤس، رغم أنّ محيط الشخصيات والثيمة يغريان بكلّ ذلك. السرّ يكمن في الزمن الذي أمضاه في العيش مع الشخصيات لكسب ثقتها، وحرصه على مبادلتها الثقة بالاحترام، إضافة إلى مقاربة أفلمة غاية في الفطنة، يتموقع فيها جدول فريق التصوير في نوعٍ من الانزياح مع البرنامج اليومي للشخصيات: تارةً، يسبق الفتيات عند السيدة العجوز، ليرصد استعدادات هذه الأخيرة لاستقبال الأطفال؛ وتارة أخرى، يصل متأخّراً في ساعات الصباح عند الفتيات، ليلتقط مَشاهد آسرة ومؤثّرة، لاستغراق هؤلاء الأخيرات في النوم تعباً، بينما يستيقظ الأطفال ليستوطنوا الشقة المتواضعة، عابثين بالأغراض والطعام. كأنّ في ذلك كنايةً عن نضجٍ قبل الأوان، ومسار تعلّم قاسٍ، لا يسع المُشاهد أمامه سوى التساؤل عن نوع المستقبل الذي ينتظرهم في مجتمع أبوي وتقليدي.
شهد “حضانة ليلية” عرضه الأول في فئة “فوروم”، في الدورة الـ71 (1 ـ 5 مارس/آذار 2021) لـ”مهرجان برلين السينمائي (البرليناله)”، وشارك أيضاً في الدورة الـ52 (15 ـ 25 إبريل/نيسان 2021) لمهرجان “رؤى الواقع” في نِيون (سويسرا)، قبل أن يتوّج بجائزة “الحصان الذهبي لأفضل فيلم وثائقي” في الدورة الـ27 (16 ـ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021) لـ”فيسباكو”، وحلّ في خريبكة، للمشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ22 (28 مايو/أيار ـ 4 يونيو/حزيران 2022) لـ”المهرجان الدولي للسينما الأفريقية ـ فيكاك”، حيث التقته “العربي الجديد”.
(*) كيف جاءت فكرة الفيلم؟
جاءت الفكرة من شارع مزدحم للغاية في بوبو ـ ديولاسو في بوركينا فاسو، يسمى شارع “بلاك”، حيث تتعايش الدعارة والكحول والمخدّرات والنّشالون. أنا بومة ليلية حقيقية. أحبّ الليل، وأعشق السهر حيث تكون هناك أجواء احتفالية، لذلك أمضي كل لياليّ هناك، تقريباً. في البداية، عندما جئت إلى المنطقة، رأيت مجموعة فتيات ليل، وبدأت أتعاطف معهنّ، لكنْ ليس كزبون. أرى أنهنّ نساء كجميع النساء الأخريات، لكنهنّ يمارسن أقدم مهنة في العالم، والمهنة مرفوضة في المجتمع. عندما وصلت، لم يكن لديّ أي فكرة عن صناعة فيلم. تدريجياً، استقرت الثقة بيننا بعد شهرين، ثم بدأت الذهاب إلى منزلهنّ، وفي النهار، يأتين أحياناً إلى منزلي. كلّما صادفتهنّ في الشارع، أتحدث معهن، وإذا كان بإمكاني أنْ أسدي إليهنّ خدمةً يطلبنها مني، أفعل ذلك من دون دوافع خفية.
كنت أخمّن في نفسي: “هل ممكن إنجاز فيلم عنهنّ في الشارع، باستخدام الكاميرا؟ لكنّه فيلم لن يتجاوز 5 دقائق”. أنْ تقول فقط: “أريد صنع فيلم عن الدعارة”، لم يكن ليشتغل ذلك، لأنّ هناك الكثير منها. ذات يوم، سألتني إحدى الفتيات: “هل يمكنك اصطحابي لآخذ طفلي؟” أجبتها: “طبعاً، لا مشكلة”. رافقتها على دراجتي النارية، وذهبنا لاسترجاع الطفل. طلبَتْ منّي الخدمة نفسها مُجدّداً بعد أيام، واصطحبتها مرة أخرى. عندها سألتها: “نحن نعرف بعضنا منذ 5 سنوات، لكنّي لا أفهم أيّ فرد من عائلتك ينتظرك دائماً في فناء المنزل هناك، توكلين إليه طفلك”، فأجابتني بنبرة عادية: “لا، ليست من أفراد عائلتي، بل امرأة عجوز ترعى أطفال عاملات الجنس ليلاً”. قلت في نفسي: “يا إلهي!”. حتّى أنا الذي أعيش في بوبو، لم أكن أدري بوجود شيء كهذا. في اليوم التالي، عرضت عليها اصطحابها للقاء المرأة العجوز، فوافقت. عندما ذهبت إلى هناك، دخلت المنزل، ورأيت أنّ السيدة العجوز تنتظر، بينما كانت فتيات أخريات يأتين من وقتٍ إلى آخر ليودِعنَها أطفالهن ويغادرن.
منذ ذلك اليوم، أدركت أن هناك فيلماً ينبغي أن يُصنع. بدأت الكتابة، واستغرقت عملية تحقيقه 10 سنوات، من نشوء الفكرة إلى المونتاج النهائي. أمضيت وقتاً كثيراً مع الفتيات والسيدة العجوز لتحقيق ذلك.
(*) لكنْ، ليس سهلاً، في مجتمعات يقوضها ضعف هياكل الإنتاج السينمائي، تحقيق فيلم كهذا حول ثيمة معقّدة.
الأمر صعب جداً. في البداية، عندما كنت أقدّم فكرة العمل، أو أتحدث عنها مع منتجين، أتلقّى دائماً ردوداً مثل: “لا، فيلمٌ آخر عن الدعارة؟ لن ينجح ذلك”. ذهبت مرّة إلى السنغال بحثاً عن منتجين، لكنْ لا أحد اهتمّ بالمشروع. نظراً إلى أنّ الموضوع تابو، يُنظر إليه بسوء، كان العثور على منتج معقداً.
هناك “أفلام دجابادجاه” (Djabadjah شركة إنتاج من بوبو ـ ديولاسو، المحرّر) وثقت بالمشروع، فانطلق كلّ شيء. تحقّقت الخطوة الثانية بفضل “فيلم أواغا لاب (Ouaga film Lab) عام 2017، عند الحصول على دعم صندوق في إطار “فيسباكو”، اسمه “صندوق الإبداع الفرنكوفوني”. بفضل ذلك، أتيت إلى الدار البيضاء في إطار “إقامة كتابة، نظّمها هشام فلاح في الـ”فيدادوك” (المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأغادير، المحرّر). هناك، تأكّدت أنّ بإمكاني صنع فيلمٍ إذا توافرت لي الإمكانات. نتيجة لذلك، قدّمت طلباً، وكان الدعم الأول من “صندوق الشباب الفرنكوفوني”. ثم توالت مبادرات الدعم، وصولاً إلى صندوق “تكميل” من “أيام قرطاج السينمائية”.
(*) حان موعد التصوير. أتخيّل أنّه كان معقداً في حيّ صعبٍ، كما وصفته. ما العقبات الرئيسية التي واجهتك، وكيف تمكنت من التغلّب عليها؟
كما أسلفت، الفتيات والمرأة العجوز يعرفنني جيداً، ويعلمن أنّي أشتغل في السينما. لذا، لم تكن هناك مشكلة في البداية. كانت الصعوبة عند حصولي على المال، فرغم أنّي أستطيع التصوير بنفسي، قرّر الإنتاج التعاون مع مدير تصوير “أبيض”، اسمه بيار لافال. في اليوم التالي من التصوير، حصل ما نطلق عليه في بوركينا فاسو “النفاق الاجتماعي”. تعالت الأصوات فجأة من أنحاء الحي: “اسمعوا. يجب ألا نوافق على السماح بالتصوير. الرجل الأبيض هنا لالتقاط صورتنا كي يبيعها في أوروبا. إلخ”.
ثم حانت اللحظة التي واجهتني فيها السيدة العجوز بهذا. قلتُ لها: “سأشرح لك. أنا أشتغل في السينما، وصارحتك بكل العملية من البداية. تعرفين جيداً كيف وصلت إلى هنا”، فأجابت: “من أجلك فقط، سأسمح بهذا، لأنّي أثق بك. أتيت إلى هنا لسنوات، قبل مشروعك. لذا، واصل التصوير. نحن موافقون”. مع الفتيات، لم يكن لدي أيّ مشكلة، ولا حتى نقاش من هذا النوع، لأنّ اكتراثهنّ بما يقوله الناس منعدم. في شارع “بلاك”، أعتقد أنّي كنت محظوظاً، لأنّي محبوب لدى الجميع: أولئك الذين يعملون في الشارع، والنشّالون وتجار المخدرات. جميعهم يحترمونني. لمظهري المميّز ودراجتي الكبيرة دورٌ في ذلك ربما. لم أواجه أيّ مشكلة مع هؤلاء قَطّ، رغم أنّ الشرطة نفسها تواجه صعوبة في تطبيق قانونها في الحيّ.
عندما أكون هناك، ويحدث شِجارٌ، أتمكّن أحياناً من تهدئة الأمور. ليس لأنّي قوي، بل لأنّ لدي علاقة احترام مع الجميع. جميع هؤلاء يرفضهم المجتمع ويستهجنهم. أنا لم أعاملهم يوماً بهذه الطريقة. يمرّ أحدهم ويصرخ بي: “آه، القط، كيف حالك؟ هل تستطيع أنْ تبتاع لي زجاجة كوكاكولا؟”، أو: “هل يمكنك أنْ تصنع لي معروفاً؟”. إذا استطعت، أسدي له الخدمة من دون تردّد. في الشارع، عندما بدأنا التصوير، كنت دائماً خلف الكاميرا، لكن بعيداً قليلاً كي لا يناديني المارة كلّ الوقت، فيُسمع ذلك على الشريط الصوتي. كان بيار لافال يصوّر، وما إنْ يلحظه أشخاصٌ ويهمّون بالاحتجاج عليه، حتّى أرفع يدي مشيراً إليهم من بعيد، فيقولون: “آه طيب. دعه وشأنه. إنّه مع القط”. هكذا تمّ الأمر.
المدهش أنّ هناك أشخاصاً كانوا سعداء بتصويرنا. عندما أفكّر في أنّنا استطعنا تصوير فيلمٍ في مكان حيث يمكنك بالكاد تشغيل المصباح على هاتفك، حتّى يتجمّع حولك أشخاصٌ ليسألوك عما تفعله، فضلاً عن خطر السرقة، والدخول في شجار. كنت محظوظاً بحقّ.
(*) تحدّثت كثيراً عن الثقة لوصف العلاقة التي أنشأتها مع شخصياتك. لكنّ هذا النوع من التقارب يمكن أنْ يهدّد بتجاوز خطوط العلاقة الاحترافية اللازمة في فيلم وثائقي، ولا سيما عندما يكون الموضوع صعباً، ولا تعرف ماذا تعرض مما لا يصلح للعرض أمام المُشاهد؟
أعتقد أنّ الوقت الذي أمضيته مع الشخصيات سمح بمعرفة حدود هذه العلاقة. عندما يصل زبونٌ في أثناء تصويرنا فتاةٍ مثلاً، كلّ ما عليها فعله أنْ يُلوّح لي، لأفهم أنها ستتحدّث إليه كي أتركها وشأنها. أقول دائماً للمُصوّر أنْ يقف حيث أطلب منه. لم نحتَجْ إلى تنفيذ حركات بكاميرا معقّدة على أيّ حال، لأنّ حركة الفتيات تحصل ذهاباً وإياباً في الحيّز نفسه، في مقابل مكان مرور الزبائن. أحياناً تخرج الفتيات من الإطار، فلا نتبعهنّ، لأنّنا متيقّنون من عودتهنّ إلى الصورة. عندما تناقش الفتيات شخصاً أهتمّ بخدماتهنّ، ويمنحنني الإشارة إلى إمكانية مواصلة التصوير، أقول لفريقي: “لسنا بحاجة إلى سماع ما يقال”. نرى أنها تتحدث مع زبونها، ثمّ تصعد على الدراجة النارية. هذا كلّ شيء. هذا يكفي تماماً.
(*) كحال مَشاهد العلبة الليلية، الأجواء هي ما يَهمّ.
بالفعل. ساعدني الوقت الذي أمضيته مع الفتيات، ومعرفتي بديكور الحيّ منذ سنوات، كما أعرف راحة يدي. يبدو الأمر كأنّك تسير بعينين مغمضتين في منزلك، ويمكنك مع ذلك معرفة المدخل والمخرج. تتحكم بالأمور بشكل تامّ، ما يجعل توجيه فريقك سهلاً عليك.
(*) هناك مشهد رائع، تتمازح فيه الفتيات حول تجاربهنّ مع الرجال الذين اعتادوا إتيان نشوتهم بطريقة غريبة. ما قصة هذا المشهد؟
يتعلّق الأمر دائماً بتمضية وقتٍ طويل معهنّ. في اليوم السابق، كنا في “بلاك”، فنشب شِجَار بين فتاة وزبون حول مسألة تتعلّق بوقت الاستمتاع. ضحكنا كثيراً لذلك، وذهبنا جميعاً بعدها إلى المنزل. عادةً، تتسامر الفتيات بعد أن يحصلن على مال كافٍ في الليلة السابقة. كنّ مبتهجات، فبدأن يتحدثن عمّا حدث. بعد أن أمضينا ساعات عدّة في التصوير، شرعن يحكين كيف أنّ مهنتهنّ ليست سهلة. روت كلّ واحدة منهنّ تجربةً عاشتها، فقرّرت أخذ القليل منها فقط. كانت لدي مواد كثيرة ذهبت في هذا الاتجاه، لكنْ ينبغي ألاّ يُثقِل الحديث عن النشاط الجنسي للرجال كاهل الفيلم. راقتني مقاطع تحدثهنّ عن الرجال، لأنّها أضحكتهنّ، فقرّرت الاحتفاظ بها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس