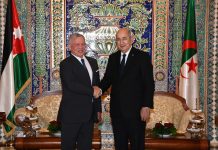أفريقيا برس – الجزائر. المحلل الاقتصادي والمالي جلال بوسمينة، هو خريج الجامعة الجزائرية، يواصل تكوينه في الولايات المتحدة الأمريكية، ودائم الحضور في شبكات التواصل الاجتماعي لتحليل وقراءة الشأن الاقتصادي والمالي في الجزائر، فضلا عن الاعلام الجزائري والعربي.
وهو شخصية اقتصادية لا تعتمد الاثارة لدرجة التهويل، ولا التجاهل لدرجة التهوين، وفي رده على أسئلة “أفريقيا برس”، شدد على ضرورة القراءة الاقتصادية والاستثمارية لمشروع قانون المناجم، بدل الخوض في المسائل السياسية عبر بوابة “السيادة الوطنية”، متوقعا مساهمة القطاع في تنمية العائدات الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التجارب العالمية، على غرار استراليا.
واعتبر العبرة في استغلال الثروات الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات، وليس تهويل مسائل أمّنها القانون نفسه، لكنه في المقابل أكد أن مشكلة الاقتصادات لا تكمن في الريع، بقدر ما تكمن في كيفية تسيير وتثمين ذلك الريع، وأن الريع الجزائري لا يقارن بما هو موجود في استراليا أو النرويج، لكن تثمينه وتسييره وتحويله الى رافعة لصناعة الثروة، هو المفتاح الذي يحدد المسار الحقيقي لأي اقتصاد في العالم.
كالعادة سيتم تبني الموازنة العامة للعام القادم، كيف قرأتم المشروع؟
مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي ينتظر تبنيه كموازنة عامة للدولة لا يختلف كثيرا عن سابقاته من حيث التوجهات الكبرى، إذ يحافظ على أولوية الدعم الاجتماعي والأمن والخدمات الأساسية. ورغم الحديث عن ترشيد النفقات، فإن ميزانية التسيير ما تزال تشكل الحصة الأكبر من الإنفاق العمومي، ويعزى ذلك إلى ضعف الإيرادات الجبائية التي تفرض ضغطا مستمرا على الخزينة العمومية. تقدر النفقات الإجمالية لسنة 2026 بنحو 136 مليار دولار أمريكي، مقابل إيرادات إجمالية تقدر بحوالي 60 مليار دولار. هذا يعني عجزا ماليا متوقعا للخزينة في حدود 39 مليار دولار.
الإيرادات البترولية قدرت بـ 20 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات خارج الجباية البترولية بنحو 40 مليار دولار، أما نسبة الجباية البترولية من اجمالي الجباية تشكل 38.4 بالمائة، ومن المتوقع أن تشكل نسبة أعلى من تلك المسجلة في سنة 2025 والتي كانت في حدود 36.5 بالمائة، وهذا يعود إلى توقع تراجع الإيرادات الكلية بنسبة 3.4 بالمائة، بينما ارتفعت الجباية البترولية بنسبة 4 بالمائة.
الحكومة واصلت دعم المواد الأساسية من خلال تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لاستيراد البقول الجافة والأرز، وكذلك بالنسبة للخضر والفواكه الطازجة وبيض الاستهلاك والدواجن المنتجة محليا، كما تم تمديد العمل بالمعدل المخفض للحقوق الجمركية إلى نهاية 2026 على استيراد الأبقار والأغنام ولحومها الطازجة أو المبردة، إضافة إلى القهوة. واللافت أن الخاصية الأبرز في قانون مالية 2026 هي أن تغطية العجز لن تتم من صندوق ضبط الإيرادات الذي حدد رصيده الرمزي بـ 0.01 دينار فقط، حيث ستلجأ الحكومة إلى إصدار صكوك سيادية مدعومة بحق الانتفاع من أصول الدولة ومشاريع الاستثمار العمومي كآلية جديدة للتمويل، كذلك تم رفع سقف التمويل غير التقليدي، إذ سمح للخزينة بالاقتراض من البنك المركزي بنسبة 20 بالمائة، من موارد الميزانية للدولة بدل 10 بالمائة في السابق، مع تمديد الآجال من 240 يوما إلى سنة قابلة للتجديد. غير أن هذا الإجراء، إذا استخدم خارج المهل القانونية أو دون استرجاع القروض في وقتها، قد يفاقم معدلات التضخم.
الحكومة اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، وهو تحفّظ مالي مقصود، إذ يتوقع أن يكون السعر الفعلي أعلى من 80 دولارا أو أكثر، ما قد يسمح بزيادة الإيرادات الفعلية وتقليص العجز في نهاية السنة؟
قانون مالية 2026 يحافظ على نفس التوجه الحكومي التقليدي مع إدخال آليات جديدة لتعبئة الموارد كالصكوك السيادية والاقتراض المحدود من البنك المركزي، ويهدف إلى تحقيق توازن بين ترشيد النفقات وتنويع الإيرادات. ورغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تبقى في حدود 47 بالمائة، إلا أن استمرار العجز بمستويات تفوق 20 بالمائة من الناتج (ما يعادل 71 مليار دولار) قد يشكل تحديا خطيرا على المدى المتوسط، إذا لم ترفق هذه السياسة بإصلاحات هيكلية أعمق.
تشابهت المحاور والتوجهات الاقتصادية للحكومة في السنوات الأخيرة، من حيث الضخامة، العجز، هيمنة التسيير على الاستثمار.. وغيرها، كيف تعلقون على ذلك؟
الحكومة تحافظ على نفس البنية العامة لقوانين المالية، رفع في الإنفاق، دعم اجتماعي، وتغطية العجز بالوسائل الداخلية. وواضح جدا أن أولويات الحكومة لا تزال اجتماعية، فهي تحاول التحكم في التوازنات الاجتماعية قبل التحول الهيكلي، خاصة بعد زيادة الواردات وارتفاع مداخيل الاستثمار في قطاع المناجم والصناعة التحويلية.
هيمنة ميزانية التسيير على التجهيز ناتجة عن قطاع عام واسع وعدد كبير من الوظائف، مع ضعف في إيرادات الخزينة حتى الآن، مما يخلق ضغطا متواصلا على الموازنة. يضاف إلى ذلك ميزانية كبيرة موجهة للدعم الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي التحويلات الاجتماعية المتوقعة لسنة 2026 عبر الصناديق والهيئات الاجتماعية نحو 16.7 مليار دولار، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي الدعم الاجتماعي إلى 42 مليار دولار أي بنسبة 32 بالمائة من إجمالي النفقات، وهي نسبة كبيرة تجعل الحكومة مضطرة دائما إلى منح الأولوية لميزانية التسيير على حساب ميزانية التجهيز.
أما العجز المتوقع فهو يختلف عن العجز المحقق في نهاية السنة، لأن متوسط تنفيذ ميزانية النفقات في الجزائر لا يتجاوز 70 بالمائة، ومن جهة أخرى تعتمد الحكومة منذ سنوات سعرا مرجعيا للنفط في حدود 60 دولارا للبرميل، وهو أقل من متوسط سعر النفط الفعلي سنويا، ما يجعل الإيرادات المحصلة في نهاية السنة أعلى من الإيرادات المتوقعة في الميزانية. ومع ذلك يبقى العجز متحكما فيه حتى الآن، خاصة أن الدين الداخلي لا يزال مستقرا في حدود 47 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا تتعدى نسبة الدين الخارجي 1.2 بالمائة، هذه العوامل تجعل العجز تحت السيطرة في الوقت الحالي، لكن الخطر يكمن في تراكمه وفي طبيعة الأدوات المستخدمة لتغطيته، مما قد يزيد من مخاطر التضخم مستقبلا.
يعاتب عدد من الخبراء اعتماد مؤشرات الاقتصاد الكلي على حساب الاقتصاد الجزئي، هل بالامكان الوصول الى توافق بينهما، وكيف؟
الاقتصاد الكلي يدرس الصورة العامة مثل النمو، التضخم، البطالة، والموازنة العامة، بينما الاقتصاد الجزئي يركز على سلوك الأفراد والمؤسسات. بيانات الاقتصاد الكلي مهمة جدا لمعرفة التوجه العام والنتائج المحققة، لكنها وحدها غير كافية، حتى وإن كانت مقروءة بطريقة علمية تأخذ في الحسبان متغيرات عديدة. لذلك تحليل بيانات الاقتصاد الجزئي يسمح بفهم الآليات الحقيقية للاقتصاد ومعرفة من استفاد فعلا من الأداء الذي تعكسه المؤشرات الكلية.
على سبيل المثال، نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمائة، هو رقم من أرقام الاقتصاد الكلي، لكن التدقيق في البيانات الجزئية يمكننا من تحديد القطاعات التي ساهمت فعلا في هذا النمو. في الوقت نفسه، الاقتصاد الكلي يبين لنا نسبة النمو 5 بالمائة، بينما الاقتصاد الجزئي مثلا مستوى الدخل الفردي الحقيقي يوضح من استفاد من هذا النمو في الواقع، وهل انعكس فعلا على سلوك الأفراد ومستوى معيشتهم. الاقتصاد الكلي لا يمكن فصله عن الاقتصاد الجزئي، والسياسات الاقتصادية الفعالة هي التي تُبنى على تكامل الاثنين.
فمثلا، تحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم في خلق الوظائف وتقليل البطالة (والبطالة مؤشر من مؤشرات الاقتصاد الكلي)، و في النهاية، الترويج للأرقام الاقتصادية بطريقة سطحية دون مراعاة المتغيرات المحيطة بها لا يعدو أن يكون دعاية إعلامية لأهداف سياسية أو ترويجية، بعيدا عن الدراسة العلمية الدقيقة للواقع الاقتصادي.
لا زالت التحويلات الاجتماعية وتأمين الرواتب والمعاشات تهيمن على موازنة الدولة، ما وجاهة هذا الخيار برأيكم، وما الجدوى من موازنة اذا عانت من العجز ولم تحرك عجلة الاقتصاد والتنمية؟
تشكيل التحويلات الاجتماعية نسبة كبيرة من إجمالي النفقات ليس أمرا عشوائيا، بل هو خيار استراتيجي تتبناه الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، ومكرس في الدستور بمادة صماء تضمن الطابع الاجتماعي للدولة. هذا الخيار يحافظ إلى حد ما على القدرة الشرائية، ويساهم في استقرار الطلب الداخلي الذي يدعم النمو الاقتصادي، كما يعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
لكن في المقابل، لهذا الخيار تكلفة مالية مرتفعة، خصوصا عندما تكون الإيرادات محدودة ويُمول جزء من النفقات بالعجز. فعندما يشكل الإنفاق الاجتماعي نسبة معتبرة من إجمالي الإنفاق العمومي، يصبح تمويل الاستثمار محدودا، مما يؤدي إلى تعطل الإنتاج وضعف خلق الثروة. كما أن مردودية هذا الإنفاق تبقى ضعيفة، لأن جزءا كبيرا منه يذهب مباشرة إلى الاستهلاك، مع استفادة فئات غير مستحقة منه بسبب غياب التوجيه الدقيق للدعم.
في الجزائر، الدعم حتى الآن غير موجه بشكل فعّال، ويحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الفلاحة. توجيه الدعم بشكل أفضل سيساهم في تقليص حجم النفقات الاجتماعية، ويمكّن الدولة من تخصيص موارد أكبر للاستثمار، مما يزيد من إيرادات الخزينة مستقبلا، ويضمن استمرار سياسات الدعم دون أن تتأثر ميزانية التجهيز. أما بالنسبة للعجز في الموازنة، فهو في الظروف الحالية أقرب إلى حتمية منه إلى خيار. فمراهنة الدولة على الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي، مع توسيع الإنفاق لتفادي الركود الاقتصادي، يضعها أمام خيار شبه وحيد وهو تمويل جزء من الميزانية عبر العجز.
هذا الخيار ليس بالضرورة سلبيا إذا كان العجز تحت السيطرة وكان الدين العام في مستويات آمنة، لأن زيادة النفقات يمكن أن تحفّز النمو الاقتصادي. غير أن استمرار هذا النهج يحمل مخاطر على التوازن المالي والنقدي، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وفي النهاية، التحدي الأكبر الذي تواجهه الموازنة الجزائرية هو محدودية الإيرادات، وهو ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة. فالحفاظ على سياسات الدعم الاجتماعي مع رفع ميزانية التجهيز لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، حتى تتمكن الدولة من تحقيق هدفي التنمية والاستقرار الاجتماعي في الوقت نفسه
تتوجه الحكومة الى المزيد من الاعتماد على الريع (النفط ثم المناجم)، هل افتقدت الجزائر إلى فرص تنويع مصادر الدخل، والتحرر من التبعية الطاقوية. بعد قانون المحروقات العام 2020؟
الريع ليس مشكلة، بل على العكس هو مصدر دخل أساسي لأي دولة، والإشكالية الحقيقية تكمن في طريقة تسيير هذا الريع وفي مدى القدرة على خلق قيمة اقتصادية مضافة منه. لدينا العديد من الأمثلة لدول متقدمة تعتمد بشكل كبير على صادراتها الريعية، استراليا الريع يمثل أكثر من 60 بالمائة، من إجمالي صادراتها، خصوصاً من قطاع المناجم، لكنها تمتلك نظاماً ضريبياً صارماً وصندوقاً سيادياً يستثمر العائدات في مشاريع إنتاجية تحقق عائداً طويل الأمد. النرويج مثال جيد أيضا على ذلك، وكذلك كندا.
بالنسبة للجزائر، المشكلة لا تتعلق فقط بكيفية تسيير الريع، بل أيضاً بقيمة هذا الريع وحجمه المحدود. فصادرات الجزائر الريعية سنة 2024 لم تتجاوز 45 مليار دولار، في حين تجاوزت صادرات استراليا الريعية 370 مليار دولار، وهذا هو الفارق الجوهري، لذلك تسعى الجزائر حالياً إلى تنويع مصادر دخلها الريعي عبر الاستثمار في قطاع المناجم لرفع قيمة الصادرات مستقبلاً، مما يسمح بتوظيف جزء من عائدات الريع في مشاريع استثمارية منتجة وخلق الثروة، إضافة إلى إمكانية تأسيس صندوق سيادي.
حتى الآن، تبقى العائدات المتواضعة سبباً في تركيز الحكومة على دعم احتياطي الصرف لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، في حين أن الاستفادة المثلى من الريع يجب أن تمر عبر تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة به، وهو ما ينبغي أن يكون من أولويات السنوات المقبلة، أما فيما يخص تنويع مصادر الدخل، فالجزائر تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر بكثير، لأن التمويل الحكومي الحالي غير كافٍ لتغطية حاجات الاستثمار نتيجة توسع القطاع العام وضغط نفقات التسيير.
دخول رؤوس أموال أجنبية سيكون عاملاً أساسياً لتنويع مداخيل الاقتصاد، خاصة أن الاستثمار الأجنبي المباشر تاريخياً كان المحرك الرئيسي لنهضة الاقتصادات الناشئة، ورغم الجهود الحالية لدعم الإنتاج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية، خصوصاً في القطاعات غير المعقدة، إلا أن ذلك لا يكفي دون انفتاح استثماري أوسع يضمن انتقال الجزائر من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي متكامل
أطلقت الجزائر قانون جديد للمناجم، أثار مخاوف وانتقادات، الى أي مدى يمكن التمييز بين السيادة وبين البراغماتية الاقتصادية في القانون المذكور؟
أولا، إن نسبة 80 بالمائة المقصودة في القاعدة 80/20 تشير إلى حصة امتلاك الشريك الأجنبي من الأسهم في رأس المال الاجتماعي للشركة التي تؤسس بالشراكة مع الطرف الجزائري، وهذه الشركة تعتبر شركة جزائرية خاضعة للقانون الجزائري في النهاية، وهو ما تؤكده المادة 66 من قانون المناجم الجديد. بمعنى آخر، الدولة تمنح رخصة الاستغلال وفق التشريع الجزائري لشركة تُنشأ داخل الجزائر وتعمل بموجب القانون الجزائري، تضم الشريك الأجنبي والشريك الجزائري معا، كما أن قانون المناجم الجديد واضح جدا في مسألة السيادة على الثروات المنجمية، وهو ما تنص عليه المادة 3 “تعد مجموعة المواد المعدنية أو المتحجرة، المكتشفة أو غير المكتشفة، المتواجدة في المجال الوطني، ملكية عمومية وطنية. تمارس الدولة حقوقها السيادية عليها، سواء على سطح الأرض أو باطنها أو في المجال البحري، في إطار التنمية المستدامة والتثمين وفقا لهذا القانون”.
ويضاف إلى ذلك حق الشفعة الذي تتمتع به المؤسسة الوطنية، كما ورد في المادة 74 من نفس القانون. لذلك، أرى أنه كان من الأجدر على المختصين مناقشة القانون في مجمله وبكل أبعاده الاقتصادية والتنظيمية، وليس الاكتفاء بالتركيز على نقطة السيادة التي حُسمت قانونيا بشكل واضح ولا لبس فيه.
نفذت الجزائر تجربة غرس مليون شجرة في يوم، وبغض النظر عن الجانب الدعائي والتطوعي، هل بالامكان الوصول الى تثمين اقتصادي وبيئي لقطاع الغابات في الجزائر؟
الجزائر تمتلك 4.1 مليون هكتار من المساحات الغابية، ما يجعل نسبة الغطاء الغابي لا تتعدى 1.7 بالمائة، من مساحة البلاد، ويعود ذلك إلى أن نسبة كبيرة من أراضي الجزائر صحراوية أو ذات مناخ جاف. غرس مليون شجرة في يوم واحد، بغض النظر عن دقة هذا الرقم، تبقى مبادرة قوية من الناحية الرمزية، من خلال نشر ثقافة التشجير، وستكون مفيدة بيئيا إذا تم الاعتناء بهذه الأشجار مستقبلا، لكن تبقى مثل هذه المبادرات غير كافية لوحدها.
من بين المشاريع الواعدة التي تعتزم الجزائر إطلاقها، مشروع شركة سوناطراك بالشراكة مع المديرية العامة للغابات، بهدف إنشاء أحواض كربون معتمدة على مساحة 520 ألف هكتار، بالإضافة إلى غرس 423 مليون شتلة تستعمل في إعادة التشجير وتجديد الغابات. و عندما نقول حوض كربون معتمد، نقصد أنه مراقب دوليا ويتم تحديد كمية الكربون الممتصة فيه، ما يجعل الجزائر قادرة على بيع أرصدة الكربون التي تمتصها مستقبلا في سوق الكربون الذي يتجه إليه العالم، والذي تشتري فيه الدول ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة هذه الأرصدة.
هذا المشروع يعد ذا بعد اقتصادي مهم جدا، وفي المقابل تستورد الجزائر ما قيمته 250 مليون دولار من الخشب، ويمكنها مستقبلا بعد توسيع مساحتها الغابية تطوير صناعة الخشب لتقليص فاتورة الاستيراد. كما يمكن أيضا تطوير إنتاج المنتجات غير الخشبية مثل صمغ الصنوبر والفلين، اللذين تصدرهما الجزائر حاليا ولكن بكميات محدودة، إضافة إلى ذلك، يمكن تطوير السياحة الغابية التي تخلق مناصب عمل، إذ تشير الإحصائيات إلى أن كل 1000 هكتار غابي مخصص للسياحة يمكن أن يوفر ما بين 200 إلى 300 منصب شغل. أما من الجانب البيئي، فالجزائر تعاني من ظاهرة التصحر، خاصة مع التغيرات المناخية. ويسهم الغرس المكثف في الهضاب العليا في الحد من تدهور التربة، ما يقلل خطر التصحر. كما تساعد الغابات في خفض درجات الحرارة في المناطق المجاورة وزيادة التساقطات المطرية، مما يسهم في التخفيف من مشاكل الجفاف التي تفاقم تكلفة المياه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس