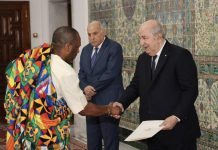سعيد خطيبي
أفريقيا برس – الجزائر. ألفت زيارة المقابر، لاسيما منها المقابر الحربية، أتلصص على الأسماء المكتوبة على الشواهد، لمجندين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، من بينهم جزائريون. هؤلاء الجزائريون لم تدون معلوماتهم كاملة، فقد كانوا أرقاماً في الماضي، ولا نعثر في بعض الأحيان سوى على اسم الشخص دون لقبه العائلي، بلده الأصلي وتاريخ مماته، فلا نعرف تاريخ ميلاده.
يبدو كما لو أنهم مجهولون في حرب مجهولة، خصوصا في إيطاليا، في تلك الجبهة وقعت أعتى المعارك، على خط غوستاف الدفاعي الذي كان يقطع البلاد شرقاً وغرباً، فيحمي روما من زحف الحلفاء، لكن في 1944 سقط ذلك الخط الدفاعي، جرى تحرير إيطاليا وراح ضحية المعارك ما لا يقل عن خمسين ألف رجل، لسنا نعرف عنهم سوى القليل، بينما نذكر من نجوا من تلك المعارك، من أمثال محمد بوضياف، أحمد بن بلة، كريم بلقاسم، فالثلاثة سوف يعودون إلى الجزائر، ويصيرون من قادة حرب التحرير ضد فرنسا (الاثنان الأولان سيصيران رئيسين للبلاد). لكن أليس من الظلم ألا يتحدث أحد منهم عن الموتى؟ كما لو أن البطولة حق للأحياء فقط، أما من قضوا فقد انتهت سيرتهم بمجرد أن اخترقت رصاصة رأسهم أو وقعت أرجلهم على لغم.
لقد طرأت، في سنين ماضية، محاولات في تدوين سير من مات في تلك الحرب، في استعادة تاريخ أولئك الجزائريين المنسيين، وقصد الإلمام بالموضوع فالأمر يستلزم صبراً وجهداً في جمع تلك الشهادات، على قلتها، قبل الخروج بتصور أقرب إلى الواقع عما حصل في الأربعينيات، وكيف وجد جزائريون، من فلاحين وأناس بسطاء، أنفسهم منخرطين في حرب لا يد لهم فيها.
الموت مقابل الاستقلال
توجب على الفرنسيين أن يعثروا على ذريعة يقنعون بها الجزائريين على لبس البزة العسكرية والسفر إلى الجبهة الإيطالية، ولم يجدوا أفضل من الوعود قصد استمالة الشباب، والوعد الأشهر: في حال تحرر فرنسا من النازية سوف تنال الجزائر أيضاً استقلالها ويُغادرها الاستعمار. ذلك الخطاب روج له في المساجد وكان حجة آمن بها الكثيرون، فسارعوا إلى لبس الخوذات، مستفيدين من تدريب قصير الأمد، قبل أن يجدوا أنفسهم في ساحات المعارك، في الخنادق وخلف المتاريس، في الغابات أو على سفوح الجبال، في مقابلة النازيين وجنود المحور.
أما المطية الثانية في استمالة الناس فكانت وعوداً نقدية.. وعدهم الفرنسيون بتعويضات، ومن يتقدم إلى التجنيد فسوف تنال عائلته راتبا رمزياً إلى غاية عودته (كما لو أنهم كانوا متأكدين من عودتهم التي لم تحصل للآلاف منهم) فمقابل عيش كريم في جزائر كان الفقر يقطع أوصالها، ركب شباب بواخر وطائرات نقلتهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط. أما العامل الثالث فلم يكن وعداً، بل قسوة، في تجنيد إجباري لكل من اجتاز الامتحان الطبي بنجاح، ولا ضرر إن كانت سنه أقل من الثامنة عشرة. لم يكن التقدم إلى الثكنات قصد التجنيد امتحاناً سهلاً، بل أشبه بجنازة. كان أولئك الشباب يتوجهون إلى الثكنات مرفقين بعائلاتهم ـ في الغالب ـ والذين يشيعونهم كمن يشيع ميتاً إلى مثواه الأخير، مقتنعين بأن آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم لن يعودوا إليهم، ومن عاد منهم بعد نهاية الحرب، كان ينظر إليه كمعجزة، فالنجاة من تلك الحرب أشبه بالنجاة من عزرائيل.
حقيبة ظهر
لا تتوافر شهادات جزائريين عن ويلات تلك الحقبة، لذلك نضطر على الدوام إلى التماس شهادات الفرنسيين، من قادة الحرب أو من مجندين، الذين يتحدثون بالدرجة الأولى عن أنفسهم، ولا يذكرون كتائب الرماة الجزائريين عدا نادراً، مع ذلك فإن التقليب في صفحات شهاداتهم، قد يوفر للباحث شذرات عما عاشه الأجداد في الجبهة الإيطالية، ومن بين المعطيات المتاحة، هي توصيف لما تتضمنه حقيبة ظهر مجند من شمال افريقيا (هكذا كانوا يوصفون، فمن بينهم كان مغاربة وتونسيون أيضاً).
يحملون على ظهورهم حقائب لا يقل وزنها عن الثلاثين كيلوغراماً، تحتوي على بوصلة، خريطة، خراطيش الرصاص، بطانية، مصباح كهربائي، الأكل المعلب، خيمة، أدوية وضمادات، قنابل يدوية، لكن أسوأ شيء كان على البعض تحمله: هو كاشف الألغام، تلك الآلة الثقيلة التي لا يقل وزنها عن 12 كيلوغراما، يتداولونها في ما بينهم كلما تقدموا خطوة إلى الأمام، ولا يحق لهم التخلي عنها حتى في حال مطاردة العدو لهم. لم يكن المجند الجزائري يتحمل ثقل الحرب فحسب، بل ثقل حقيبة الظهر أيضاً، وكان عليه أن يتعلم في وقت وجيز كي يحفر الخنادق ويفجّر المغارات كي لا يسمح للنازيين باحتلال مواقعهم، وكيف يعد المتاريس، والأهم من ذلك أن ينجو من الأسر.
فقد شاعت بين الجزائريين، في الحرب العالمية الثانية، أخبار سيئة عن شكل تعامل جنود المحور مع الأسرى، هناك من يقول إنهم يعدمونهم تحت عجلات دبابة ثم يدفنون في حفر جماعية، وهناك من يقول إنهم يعدمون بالغاز، وذلك أسوا أنواع الموت ـ كما قالوا. كان عليهم أيضاً التعامل مع مجندين آخرين من جنسيات أخرى، من عمق افريقيا أو من مستعمرات المحيط الهندي، بالإضافة إلى فرنسيين، بالتالي لم تكن حربا على جبهة واحدة، بل على جبهات متعددة، فقد لزمهم الاندماج في أقصى سرعة مع رفاق يجهلون ثقافتهم أو لغتهم، وأن يدركوا أن نجاتهم تتأتى من قتل عدوهم، مع أنهم في الغالب لم يتوافروا سوى على حربة، وهي رشاش يتقدمه خنجر للقتال المباشر، ذلك هو السلاح الأكثر شيوعاً بينهم، لذلك وجدوا أنفسهم عاجزين أمام القذائف ودبابات العدو، وسقط منهم الآلاف لا يعرف أحد أسماءهم الكاملة، عدا موطنهم الأصلي، وهم يرقدون الآن في مقابر منسية، في إيطاليا، كما يرقد بعضهم الآخر في فرنسا.
هؤلاء الجزائريون الذي شاركوا في تحرير مُستعمرهم من النازية، بدل أن يعودوا في صناديق فيدفنهم أهلهم صارواً نسياً منسياً، والأسوأ ألا نعثر ـ في الجزائر ـ على كتاب واحد يوثق جيلاً كاملاً من المحاربين الجزائريين (إذا استثنيا فيلم «أنديجان» لرشيد بوشارب) الذي ضاعوا بين جبال وغابات وشعاب الحرب العالمية الثانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس