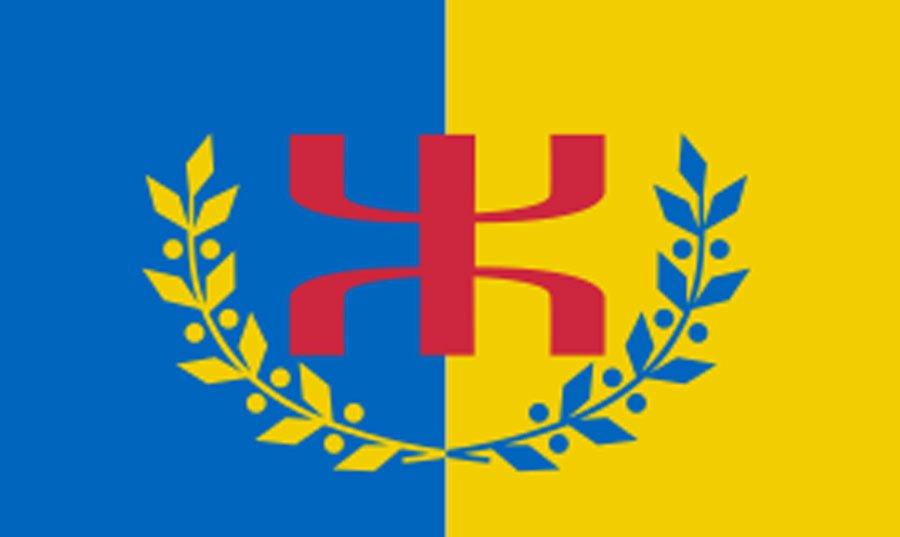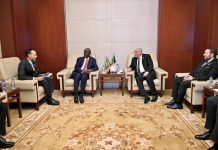بقلم : ناصر جابي
أفريقيا برس – الجزائر. الماك لمن لا يعرفها من القراء، هي الحركة التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل عن الجزائر. انتقلت في مطالبها من الجهوية الموسعة القريبة من الفيدرالية، لتصل إلى مطلب الاستفتاء المفضي إلى الانفصال عن الجزائر، التي انطلقت لاحقا في التعامل معها كقوة استعمارية، حركة ظهرت في 2001، بعد أحداث ما سمي بالربيع الأسود، الذي زهقت فيه أرواح أكثر من مئة شاب من أبناء المنطقة. حركة تم تصنيفها من قبل السلطات العمومية في الجزائر في مايو 2021 كحركة إرهابية للوصول في الأسبوع الماضي إلى المطالبة باستئصالها، بحجة أنها تعمل ضد الوحدة الوطنية، وتتلقى دعما من دول معادية للجزائر. تطور حصل بسرعة فائقة في موقف السلطة، بعد موجة الحرائق التي عاشتها منطقة القبائل هذا الصيف 2021، ارتبطت بحرق وسحل الشاب جمال بن إسماعين بمنطقة القبائل، التي أعادت شحن الصراعات الهوياتية بقوة.
حركة ما زالت محدودة الحضور شعبيا وسياسيا في الجزائر- كما بينه موقف حزب جبهة القوى الاشتراكية بداية هذا الأسبوع – وعلى التراب الفرنسي الذي تقيم فيه قيادتها الممثلة في الوقت الحالي بمطرب قبائلي معروف هو فرحات مهني، كان ضمن صفوف التجمع من أجل الديمقراطية، قبل الانفصال عنه، والتوجه نحو تبني الأطروحات الأكثر تطرفا وغلوا داخل الحركة الأمازيغية في الجزائر، والمنطقة المغاربية، والترويج لها بين أبناء منطقة القبائل الذين عرفوا، عكس هذا التوجه، بمستوى اندماج كبير جدا داخل النسيج الاجتماعي الاقتصادي والسياسي الوطني.
مدخل الاندماج المهم بكل مستوياته، الديمغرافية الاجتماعية والسياسية، الذي سيكون بداية حديثنا عن حركة الماك، لمعرفة لماذا ظهرت في منطقة القبائل بالذات، وليس مناطق أمازيغية أخرى كثيرة، لم تعرف قوة الاندماج نفسه الموجود في منطقة القبائل، لتعكس أمام نوع من الفرملة داخل هذه المنطقة، وتعبير عن تخوف ورفض، لهذا الاندماج الكبير الذي يمارسه ويعيشه أبناء منطقة القبائل يوميا في علاقاتهم بمجتمعهم الجزائري، منذ زمن طويل. عبر عدة مستويات منها الديمغرافي الذي تمثله نسبة الزواج العالية جدا لبنات وأبناء المنطقة مع باقي أبناء الجزائر خارج وداخل المنطقة، بكل تبعات هذه الروابط العائلية عندما تنتقل إلى المستوى الجغرافي، الذي يعبر عن نفسه بذلك الانتشار الكثيف لأبناء وبنات المنطقة في كل ربوع الجزائر وفي المهجر. الحضور نفسه وربما أكثر، نجده على المستوى الاقتصادي – المالي والإداري. تقوم بإنجازه نخب فاعلة داخل دواليب المؤسسة الاقتصادية والإدارية العمومية والخاصة، من أبناء المنطقة كما تعودوا على ذلك، عبر محطات تاريخية عديدة، على غرار مرحلتي الحركة الوطنية وثورة التحرير. حضور بدأت تصوره بعض الأوساط من خارج المنطقة كتغول وهيمنة لأبناء «أقلية لغوية وثقافية» تمكنت من السيطرة على دواليب المؤسسات وإبعاد «أغلبية» بفعل استفادتها المبكرة من التعليم، وقربها من العاصمة، وهجرة أبنائها القديمة لفرنسا، واستعمالها المفرط للحافز الجهوي الذي تشجعه الخصوصية اللغوية والثقافية، في مجتمع تقول المعاينة اليومية إن استعمال الجهوية بين أبنائه ليست حكرا على أبناء منطقة محددة، فهي أقرب للرياضة الوطنية، يمارسها كل أبناء الجهات.
أوساط وجدت ضالتها أخيرا في الوسائط الاجتماعية للتعبير عن هذا التذمر، الذي يأخذ تعبيرات عنصرية في بعض الأحيان، ما اعتبرته هيمنة من أبناء منطقة القبائل، على مقاليد السلطة بمختلف أشكالها في البلد، في جو سياسي متشنج ومشحون.. عرفنا لاحقا أنه كان مُسيّرا من قبل مراكز قرار مركزية، عبرت عن نفسها بواسطة حملات – ذباب إلكتروني – ما زالت حاضرة لحد الساعة، زاد منسوبها أثناء فترات الحراك الشعبي، لكسر قيم التضامن التي ظهرت بقوة بين الجزائريين، كما هي الآن، بعد موجة حرائق الغابات التي عرفتها منطقة القبائل وجهات أخرى من التراب الوطني. خوف من هذا الاندماج الكبير، الذي عبّر عن نفسه من جهة أخرى داخل المنطقة، من خلال أطروحات ثقافوية، تبنتها جموع – ما زالت قليلة حتى الآن – ركزت على التميز والنقاء الثقافي، وحتى العرقي، في بعض الأحيان، القريب من أطروحات أقصى اليمين الثقافوي، الذي أنتجته تيارات العولمة الضاغطة في الكثير من البلدان.
استغل في الحالة الجزائرية، تداعيات التسيير السيئ لمسألة التنوع الثقافي واللغوي الذي قامت بها النخب السياسية الرسمية، بداية من الاستقلال، بضيق أفقها الفكري المعروف عنها وانقساميتها اللغوية والثقافية ومنبتها الريفي المغلق. تسيير ساهم بقوة في الزيادة في منسوب الاستقطاب السياسي، بين المكونات الثقافية الوطنية، داخل ساحة إعلامية وثقافية ملغومة ومغلقة، لغاية الفترة الأخيرة التي عرفت نوعا من الانفراج، بعد الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية على مراحل 2012-2016. منسوب استقطاب زاد بشكل واضح بعد المواقف السياسية الدولية التي اتخذتها حركة الماك وهي تتوجه هذه المرة نحو “إسرائيل” مباشرة، لطلب دعمها وإقحامها في قضية داخلية بعيدة عنها، كشكل من أشكال الاستفزاز والزيادة في حدة التشنج الداخلي، كما تعودت القيام به وجوه أمازيغية ضعيفة الحضور والتأثير في كل المنطقة المغاربية – المغرب والجزائر تحديدا.
مبادرة لم تجد أي صدى شعبي فعلي على أرض الواقع، تم التعامل معها كاستفزاز للعمق الوطني، تماما كما فعلت وهي تتوجه نحو المخزن المغربي وهو يتحدث عن دعمه لمسار استقلال «الشعب القبائلي» محولا بذلك العمق الأمازيغي المشترك بين أبناء المنطقة المغاربية، إلى عامل فرقة وتنافر. هو الذي كان على الدوام عامل وحدة وتجانس داخل البلد نفسه وبين بلدان المنطقة المغاربية. وهو ما يحيلنا إلى التطرق لمسألة النخبة بمختلف مكوناتها التي يمكن أن تكون عاملا مساعدا، لمسايرة هذا التوجه الثقيل الذي يعيشه المجتمع الجزائري، نحو تجانس أكبر، بين مكوناته الثقافية واللغوية، يتم التعامل فيه مع ظاهرة الماك كنوبة حمى عابرة، أصابت المجتمع الجزائري، نتيجة حالة عسر هضم لهذه التحولات السريعة التي عاشها على مختلف الصعد، تكون قد أخافت بعض القوى الاجتماعية المحدودة، لم تتمكن من مسايرة هذه التحولات السريعة فحاولت فرملتها. دور منوط بكل مكونات النخبة الرسمية والشعبية، السياسية والفكرية، التي يجب أن تتصدى لهذا الوضع، من دون تهويل ولا تهوين، رغم المعوقات المعروفة عن النخبة الجزائرية، مثل انقساميتها اللغوية والثقافية، التي زادت في عمق الشروخ الثقافية الاجتماعية ولم تخفف منها، وقلصت من أدوارها كنخبة وطنية في مجتمع متحرك تسود داخله ثقافة شعبوية معادية للتميز والنجاح، لصالح أشباه متعلمين أقرب لمنطق الغوغاء، أنتجهم نظام تعليم سيئ. تمكنوا من التمترس داخل الوسائط الاجتماعية لاستعمالها كأدوات حرب أهلية افتراضية عبرت عن وجهها القبيح خلال هذا الصيف الحزين الذي عاشته الجزائر.